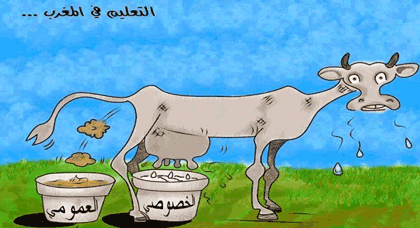
ناظورسيتي/ أشن محمد
إن ما يلفت نظرك في هذه السنوات الأخيرة، وأنت تتجول في شوارع مدينة الناظور ونواحيها، هو كثرة العربات الخاصة بالنقل المدرسي الخصوصي، التي تحمل ألوانا زاهية وأسماء جذابة، لكن ما يجمع بينها هي الأعداد الكبيرة من البراعم الصغيرة التي تتكدس داخلها والتي لا تظهر من نوافذها المحجبة إلا رؤوسها !. أما إذا اتجهنا إلى منطلق هذه العربات ومقصدها فإننا نجد بنايات لعمارات ومنازل لا تختلف كثيرا في شكلها وحجمها عن مثيلاتها التي يقطنها السكان ويمارسون فيها أنشطتهم الاقتصادية من تجارة ونجارة وغيرها... داخل أحياء وأزقة مكتظة وسط المدينة،لا نكاد نميزها إلا باللافتات واللوحات التي تحمل أسماء ’’ مؤسسات تعليمية’’. أما خارج المدينة فإننا نجدها أكبر حجما وأفضل شكلا، في أحياء بدأت تعرف توسعا عمرانيا لكنه جافا، لم يوازيه تأطيرا اجتماعيا للدولة خاصة من جانب المؤسسات التعليمية التي تنعدم فيها، مما جعلها تربة خصبة لنجاح مثل هذه المشاريع الفارة من حرارة الأسعار الملتهبة للعقار وسط المدينة. إن مايميز هذه المؤسسات عن بعضها البعض هي الأسماء التي تحملها، وهي أسماء جميلة حقا. لكن هل لهذه الأسماء دلالة ومضمون في الواقع العملي لهذه المؤسسات؟. لنترك أسماء هذه المؤسسات ومرفولوجيتها وموقعها جانبا ونتوغل داخلها كي نرى حقيقتها. إن من الدواعي الأساسية التي تدفع الآباء و الأولياء إلى تسجيل أبناءهم في المؤسسات الخاصة هو البحث عن الجودة والمردودية في التعليم التي يعتبرونها مفقودة في المؤسسات العمومية، لذلك يسعون إلى شراءها مهما كلفتهم من ثمن! فماهي الشروط التي تصنع الجودة وتعطي المرد ودية في التعليم ؟.
1- الفضاء التربوي والتعليمي
إن الطفل أو التلميذ يحتاج إلى فضاء ملائم لاحتواء تحركاته وأنشطته التي تناسب مراحل نموه . فهل تتوفر في هذه المؤسسات مواصفات المدرسة كفضاء رحب يتسع لهذه الأعداد الهائلة من التلاميذ الذين يقصدونها؟
أول ملاحظة لزائر هذه المؤسسات هو الاكتظاظ، فإذا كانت المؤسسات العمومية تعاني من هذه المعضلة التي ترجع إلى كون الحجرات رغم اتساعها تتحمل أكثر من طاقتها، وهي من الأسباب التي تدفع الأولياء إلى تسجيل أبناءهم في المؤسسات الخاصة، فإن هذه الأخيرة تعرف اختناقا. لكون أن حجراتها لا تعدو أن تكون إلا مجرد غرف صغيرة داخل منازل وعمارات مغلقة، تفتقد إلى فضاءات واسعة كالساحة والملاعب الرياضية التي يتنفس فيها التلاميذ خاصة في فترات الاستراحة ، حيث يتناوب التلاميذ على رقعة ضيقة داخل بهو العمارة أو فوق سطحها ، وهذا يحد من حرية التلميذ وحركيته الضرورية التي ترتبط بمراحل نموه كطفل. وينعكس ذلك عليه سلبا من خلال انفعالات القلق وقلة التركيز التي تظهر عليه داخل القسم. وما يزيد الأمر تشديدا هو أن التلميذ عند خروجه من الفصل يجد في انتظاره عربات النقل التي تقله إلى منزله. هذا النظام الروتيني الذي يعيشه التلميذ يوميا يجعله ينظر إلى هذه المؤسسات كسجن يسعى دائما للتخلص منه بمجرد وصوله إلى منزله، حيث ينغمس في اللعب مع أصدقاءه أو في حاسوبه أو التفرج على التلفاز، حيث يفرغ مكبوتا ته دون أن يبذل أي مجهود دراسي أكثر في بيته. لأن هذا الفضاء غير صحي تربويا، ولا يساعد التلميذ على إبراز طاقاته والتعبير عنها بكل حرية ، وهذا يؤثر على شخصيته- خاصة إذا استمر لمدة طويلة في مؤسسة واحدة- التي تفقد عدة مقومات لنضجها بسبب تقوقعها في مكان واحد وحرمانها من الانفتاح على فضاءات أكثر رحابة وتنوعا وعلاقات أكثر اختلافا وتعددا من شانها أن تبني شخصية متوازنة ومنفتحة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه المؤسسات تفتقر إلى أبسط الوسائل والتجهيزات التربوية والتعليمية، فإذا كانت مؤسسات التعليم العمومي تعرف نقصا كبيرا في التجهيزات والوسائل الضرورية للعمل بسبب ضعف الإعتمادات المخصصة لهذا القطاع، فإنها مع ذلك تتوفر على بعض الوسائل البسيطة والضرورية لسير العملية التعليمية وإنجاز المقرر الدراسي : كالمختبرات التي تتوفر على بعض المواد والأجهزة ، والمستودعات التي توجد فيها بعض الصور والخرائط، والمكتبات التي تحتوي على بعض الكتب... الخ. فهذه الأخيرة نجدها غائبة تماما في بعض المؤسسات الخاصة. وهذا ما يجعلنا نتساءل عن مدى جودة ونوعية التعليم في هذه المؤسسات؟
2- الأطر التربوية والتعليمية
يسهر على تاطير وتدريس أفواج التلاميذ بهذه المؤسسات أساتذة تختلف مستوياتهم العلمية وظروفهم العملية.فالذين يقفون وراء إنشاء هذه المؤسسات ، آخر شيء يفكرون فيه لنجاح مشروعهم هو العنصر البشري، لكون أن هذا الأمر لا يطرح إشكالا في مغرب اليوم والحمد لله!. فالآلاف من الشباب يتخرجون سنويا من الجامعات المغربية وفي مختلف التخصصات، والدولة أعلنت ومنذ زمان أنها وصلت حد الاكتفاء في إداراتها ومرافقها، ولم تعد بحاجة إلى المزيد، بل إنها فتحت باب المغادرة لم يريد!. لهذا فالمؤسسات الخاصة قبل أن تفتح أبوابها تكون قد تلقت عشرات طلبات العمل من قبل هؤلاء الشباب، فتختار منهم ما تحتاج ممن تشاء ويبقى الآخرون في لائحة الانتظار حتى تكبر المؤسسة !. ولذلك نجد هذه المؤسسات في المستويات الأولى تعتمد على أساتذة رسميون ( ليس بالمفهوم القانوني) أي أنهم يشتغلون فقط في هذه المؤسسات دون غيرها، وعلى مدار الأسبوع، صباح مساء. وهؤلاء الأساتذة ذوو مستويات علمية مختلفة (الباكالوريا،Deug ، الإجازة....)، وفي تخصصات متعددة ( الآداب، العلوم، الحقوق...) وهذا شيء إيجابي بالمقارنة مع مؤسسات التعليم العمومي، لكن الشيء الأساسي الذي تفتقد إليه هذه الأطر الشابة هو التكوين في مجال التربية والتعليم، فأغلب هؤلاء الأساتذة يباشرون عملهم دون سابق تكوين. لكون هذه المؤسسات ليس لديها الوقت والاستعداد الكافيين لتكوين أطرها، لان هدفها أكبر من الأستاذ والتلميذ معا!. هذا باستثناء بعض المؤسسات التي تنظم دورات تكوينية، أياما قليلة قبل بداية الموسم الدراسي، غير أن مضمونها يكون بعيدا كل البعد عن واقع العمل داخل هذه المؤسسات، بل يكون الهدف منها توجيه الأساتذة وفق النظام السائد بالمؤسسة الذي يتماشى مع الأهداف الخاصة لصاحب المشروع. وهذا الواقع لا نجده في المؤسسات العمومية التي يخضع أطرها قبل الالتحاق للعمل بها لتكوين بيداغوجي وديداكتيكي وتجريبي في مراكز تكوين الأساتذة خلال مدة لا تقل عن سنة، يكتسب فيها الأستاذ آليات وأدوات منهجية تساعده على الاندماج في ميدان التعليم الذي يحتاج إلى شيء من الموهبة وكثير من التجربة!. أما الحديث عن وضعية هؤلاء الأساتذة المادية والقانونية فهنا الكارثة. فهي وضعية لا تخضع لقانون أو نظام ما، يسري على هذه المؤسسات باستثناء قانون الربح : فإذا كانت هذه المؤسسات حرة في فرض ما تشاء من رسوم تسجيل سنوية وواجبات شهرية (قد تصل إلى 1300 درهم شهريا للتلميذ في بعض المؤسسات)، فإنها تبقى حرة أيضا في تحديد أجرة الأستاذ الشهرية ( التي لا تتعدى 2000درهم)، باستثناء بعض أساتذة اللغة الفرنسية الذي تعرف المنطقة خصاصا إليهم بسبب قلة تخصص طلبة المنطقة في هذه الشعبة بالجامعة ، لذلك يتم جلبهم من المناطق المجاورة لمدينة الناظور مقابل بعض الامتيازات البسيطة كالسكن. وهذا على الوجه الأفضل.أما بعض المؤسسات فإنها تقتصر على تقديم تعويض عن ساعات العمل فقط (لا يتجاوز 40 درهم للساعة)، أما الساعات الأخرى وأيام العطل والعطلة الصيفية فهي أمور لا تهمها!. هذا دون أية ضمانات قانونية ، فمعظم هؤلاء الأساتذة تم تشغيلهم دون عقد أو شرط، باستثناء بعض المؤسسات التي تلجا للقانون قصد التحايل عليه والاستفادة منه، حيث يتم العقد بمشاركة طرف ثالث هوANAPIC، بموجب هذا العقد يعفى الطرفين من الحقوق الاجتماعية (CNSS) و(IGR) التي تتحملها الدولة، حيث يعتبر المستخدم(الأستاذ) مجرد متدرب(STAGIAIRE) لمدة سنتين، وهذا العقد غير ملزم للطرفين خلال هذه المدة، بحيث يتيح إمكانية فسخه من طرف المؤسسة المشغلة بالاستغناء عن الأستاذ في أي لحظة شاءت،أما إذا استمرت في العقد وتشبثت بالأستاذ فإنها تحرمه سنتين من حقوقه الاجتماعية الناجمة عن عمله وليس تدربه بالمؤسسة!.
هذه الإكراهات المادية و القانونية إلى جانب إكراهات أخرى ، مرتبطة بسلوكيات وتصرفات تمارس على الأستاذ داخل هذه المؤسسات (لا مجال للتفصيل فيها)، كلها تجعله يعيش واقعا مرا، وظروفا صعبة، يستحيل معها القيام بدوره على أحسن ما يرام، في تبليغ رسالته النبيلة، فيصبح بذلك مردوده ضعيفا ، مما ينعكس على مستوى التلاميذ، الذين وجههم آباءهم خصيصا إلى هذه المؤسسات بحثا عن المرد ودية، وتحت ضغط هؤلاء تضطر هذه المؤسسات للالتجاء إلى أساتذة التعليم العمومي ، خاصة في الأطوار المتقدمة وتستغني في النهاية عن أطرها الخاصة.
3- الهدف التربوي والتعليمي أو الإستراتيجية
إن إبراز الشروط المادية والبشرية التي تقوم عليها هذه المؤسسات، يقودنا للحديث عن هدفها وإستراتيجيتها. فهل هذه المؤسسات تمتلك إستراتيجية تربوية و تعليمية؟ أو بصيغة أوضح هل الذين يقفون وراء هذه المؤسسات يمتلكون رؤية مستقبلية واضحة: محورها طفل اليوم، رجل الغد. ومحيطها منطقتنا الريف وبلادنا المغرب؟
من المعروف أن أساس نجاح أي مشروع في أي مجال من المجالات يتوقف على صاحبه الذي يجب أن يكون منتميا إلى المجال الذي يريد الاستثمار فيه، أي ابن المجال كما يقال. بحيث لا يمكن أن نتصور في شخص واحد: فلاحا مثابرا في حقله ، صانعا ماهرا في مصنعه، تاجرا ناجحا في متجره، عالما باحثا في مخبره... فلكل حرفته التي يتقنها، وهذا في المجال الاقتصادي. أما إذا تحدثنا عن الاستثمار في مجال التربية و التكوين، فإن المسألة أكثر أهمية وتعقيدا. وتحتاج إلى خبرة كافية و دراسة دقيقة، وتخطيط كبير. لأن المشروع مشروع إنسان، ونتائجه بعيدة المنال، مرتبطة بالأجيال!.
إذا رجعنا إلى التاريخ وجدنا أن أصل المدارس والجامعات هي أفكار ونظريات تبلورت لدى مفكرين وفلاسفة في ميادين عدة، تم جمعها وتصنيفها إلى معارف وعلوم شتى، حاولوا استثمارها، فأنشئوا لذلك مؤسسات قصد نشرها وضمان استمراريتها وتطورها في الأجيال اللاحقة. وفي وقتنا الحاضر نجد في الدول المتقدمة، خبراء في مختلف الميادين،بعد أن يقضوا أعمارهم في البحث والتنقيب عن الحقائق العلمية، ينتهي بهم المطاف إلى إنشاء مدارس ومعاهد قصد تلقين خبراتهم للأجيال الناشئة ، وفق رؤيتهم المستقبلية التي تروم تطوير ما توصلوا إليه في أبحاثهم من نتائج ستؤدي إلى تقدم العلم والمعرفة عبر الأجيال. .إذا كان الأمر كذلك عند هؤلاء، فكيف هو الحال عندنا؟
إن أصحاب الميدان عندنا أي رجال التعليم يقضون معظم حياتهم في صراع مع الزمان ومصائبه، ولا يستطيعون بناء حتى منزل يؤويهم وأبناءهم ، وبالأحرى القيام بمشروع مؤسسة تعليمية . فمعظم الذين يقومون بهذه المشاريع هم أناس لا تربطهم بميدان التعليم أية صلة، فقط امتلكوا أموالا فاستثمروها في بناء مؤسسات أصبحت تدر عليهم أرباحا طائلة ، بل إن فيهم من لا يمتلك حتى مستوى دراسي. فكيف به أن يسير مؤسسة تعليمية ويمتلك إستراتيجية تربوية؟ فهل يكفي أن يكون الإنسان مقاولا في البناء ليشيد مدرسة!؟ قد يقال بأن صاحب المشروع ليس بالضرورة هو من يشرف على المؤسسة، بل يعهد ذلك إلى طاقم من الأطر التي لها دراية بالميدان ، وهذا واقع حقا في عدد من هذه المؤسسات، ولكن أليس المنطق الذي يحكمها هو منطق صاحبها ، والأطر المسيرة تبقى مجرد أدوات ووسائل مسخرة لخدمة أهداف صاحب المشروع؟
ويكفي مثالا على ذلك أن المدير أو الحارس العام داخل هذه المؤسسات، يخضع لرغبات التلميذ وأهواءه، انصياعا لأوامر صاحب المشروع ، الذي يعتبر التلميذ رقما صعبا في معادلة مشروعه يجب احترامه، لأنه حسب منطقه زبونا، والزبون في المنطق التجاري ملكا. يتضح إذن بأن العقلية التي تتحكم في هذه المؤسسات تجارية، ليس هدفها تكوين الأجيال لبناء المنطقة والوطن، وإنما جمع الأموال لتوسيع الثروة في سباق مع الزمن. وفي الأخير نساءل هذه المؤسسات : أبهذا المنطق ستنبعث رسالة العرفان في منطقتنا وتحمل آفاقا لأجيالنا؟! أمام هذا الواقع المرير، الذي وصل إليه التعليم في منطقتنا وبلادنا عموما، حان الوقت لكي تفكر الدولة مليا في هذا القطاع لأنه أساس كل القطاعات:
- أولا: بإعادة الاعتبار إليه من خلال إصلاح جذري (وليس استعجالي) يشمل المرافق والمؤسسات، والأطر والكفاءات، والمناهج والبرامج والمقررات، حتى يعيد الثقة للأجيال الحالية ويزرع الأمل في الأجيال القادمة.
- ثانيا: بتوجيهها للقطاع الخاص وتقنينه ومراقبته، ليس على مستوى البرامج والمقررات فقط، ولكن على مستوى التنظيم ، بوضع قوانين تحدد شروط إنشاء المؤسسات الخاصة، والتزاماتها المالية والقانونية تجاه شركائها
وأطرها، وتحديد سقف أجور موحد للأساتذة المشتغلين في هذه المؤسسات حسب مستواهم الدراسي وكفاءتهم المهنية، وتمتعيهم بكافة حقوقهم الاجتماعية ، والسهر على تطبيق هذه القوانين، وذلك من أجل وضع حد للتسيب والفوضى اللذين يعرفهما هذا القطاع ، وجعله يلعب دورا مكملا للقطاع العمومي وليس بديلا عنه.
إن ما يلفت نظرك في هذه السنوات الأخيرة، وأنت تتجول في شوارع مدينة الناظور ونواحيها، هو كثرة العربات الخاصة بالنقل المدرسي الخصوصي، التي تحمل ألوانا زاهية وأسماء جذابة، لكن ما يجمع بينها هي الأعداد الكبيرة من البراعم الصغيرة التي تتكدس داخلها والتي لا تظهر من نوافذها المحجبة إلا رؤوسها !. أما إذا اتجهنا إلى منطلق هذه العربات ومقصدها فإننا نجد بنايات لعمارات ومنازل لا تختلف كثيرا في شكلها وحجمها عن مثيلاتها التي يقطنها السكان ويمارسون فيها أنشطتهم الاقتصادية من تجارة ونجارة وغيرها... داخل أحياء وأزقة مكتظة وسط المدينة،لا نكاد نميزها إلا باللافتات واللوحات التي تحمل أسماء ’’ مؤسسات تعليمية’’. أما خارج المدينة فإننا نجدها أكبر حجما وأفضل شكلا، في أحياء بدأت تعرف توسعا عمرانيا لكنه جافا، لم يوازيه تأطيرا اجتماعيا للدولة خاصة من جانب المؤسسات التعليمية التي تنعدم فيها، مما جعلها تربة خصبة لنجاح مثل هذه المشاريع الفارة من حرارة الأسعار الملتهبة للعقار وسط المدينة. إن مايميز هذه المؤسسات عن بعضها البعض هي الأسماء التي تحملها، وهي أسماء جميلة حقا. لكن هل لهذه الأسماء دلالة ومضمون في الواقع العملي لهذه المؤسسات؟. لنترك أسماء هذه المؤسسات ومرفولوجيتها وموقعها جانبا ونتوغل داخلها كي نرى حقيقتها. إن من الدواعي الأساسية التي تدفع الآباء و الأولياء إلى تسجيل أبناءهم في المؤسسات الخاصة هو البحث عن الجودة والمردودية في التعليم التي يعتبرونها مفقودة في المؤسسات العمومية، لذلك يسعون إلى شراءها مهما كلفتهم من ثمن! فماهي الشروط التي تصنع الجودة وتعطي المرد ودية في التعليم ؟.
1- الفضاء التربوي والتعليمي
إن الطفل أو التلميذ يحتاج إلى فضاء ملائم لاحتواء تحركاته وأنشطته التي تناسب مراحل نموه . فهل تتوفر في هذه المؤسسات مواصفات المدرسة كفضاء رحب يتسع لهذه الأعداد الهائلة من التلاميذ الذين يقصدونها؟
أول ملاحظة لزائر هذه المؤسسات هو الاكتظاظ، فإذا كانت المؤسسات العمومية تعاني من هذه المعضلة التي ترجع إلى كون الحجرات رغم اتساعها تتحمل أكثر من طاقتها، وهي من الأسباب التي تدفع الأولياء إلى تسجيل أبناءهم في المؤسسات الخاصة، فإن هذه الأخيرة تعرف اختناقا. لكون أن حجراتها لا تعدو أن تكون إلا مجرد غرف صغيرة داخل منازل وعمارات مغلقة، تفتقد إلى فضاءات واسعة كالساحة والملاعب الرياضية التي يتنفس فيها التلاميذ خاصة في فترات الاستراحة ، حيث يتناوب التلاميذ على رقعة ضيقة داخل بهو العمارة أو فوق سطحها ، وهذا يحد من حرية التلميذ وحركيته الضرورية التي ترتبط بمراحل نموه كطفل. وينعكس ذلك عليه سلبا من خلال انفعالات القلق وقلة التركيز التي تظهر عليه داخل القسم. وما يزيد الأمر تشديدا هو أن التلميذ عند خروجه من الفصل يجد في انتظاره عربات النقل التي تقله إلى منزله. هذا النظام الروتيني الذي يعيشه التلميذ يوميا يجعله ينظر إلى هذه المؤسسات كسجن يسعى دائما للتخلص منه بمجرد وصوله إلى منزله، حيث ينغمس في اللعب مع أصدقاءه أو في حاسوبه أو التفرج على التلفاز، حيث يفرغ مكبوتا ته دون أن يبذل أي مجهود دراسي أكثر في بيته. لأن هذا الفضاء غير صحي تربويا، ولا يساعد التلميذ على إبراز طاقاته والتعبير عنها بكل حرية ، وهذا يؤثر على شخصيته- خاصة إذا استمر لمدة طويلة في مؤسسة واحدة- التي تفقد عدة مقومات لنضجها بسبب تقوقعها في مكان واحد وحرمانها من الانفتاح على فضاءات أكثر رحابة وتنوعا وعلاقات أكثر اختلافا وتعددا من شانها أن تبني شخصية متوازنة ومنفتحة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه المؤسسات تفتقر إلى أبسط الوسائل والتجهيزات التربوية والتعليمية، فإذا كانت مؤسسات التعليم العمومي تعرف نقصا كبيرا في التجهيزات والوسائل الضرورية للعمل بسبب ضعف الإعتمادات المخصصة لهذا القطاع، فإنها مع ذلك تتوفر على بعض الوسائل البسيطة والضرورية لسير العملية التعليمية وإنجاز المقرر الدراسي : كالمختبرات التي تتوفر على بعض المواد والأجهزة ، والمستودعات التي توجد فيها بعض الصور والخرائط، والمكتبات التي تحتوي على بعض الكتب... الخ. فهذه الأخيرة نجدها غائبة تماما في بعض المؤسسات الخاصة. وهذا ما يجعلنا نتساءل عن مدى جودة ونوعية التعليم في هذه المؤسسات؟
2- الأطر التربوية والتعليمية
يسهر على تاطير وتدريس أفواج التلاميذ بهذه المؤسسات أساتذة تختلف مستوياتهم العلمية وظروفهم العملية.فالذين يقفون وراء إنشاء هذه المؤسسات ، آخر شيء يفكرون فيه لنجاح مشروعهم هو العنصر البشري، لكون أن هذا الأمر لا يطرح إشكالا في مغرب اليوم والحمد لله!. فالآلاف من الشباب يتخرجون سنويا من الجامعات المغربية وفي مختلف التخصصات، والدولة أعلنت ومنذ زمان أنها وصلت حد الاكتفاء في إداراتها ومرافقها، ولم تعد بحاجة إلى المزيد، بل إنها فتحت باب المغادرة لم يريد!. لهذا فالمؤسسات الخاصة قبل أن تفتح أبوابها تكون قد تلقت عشرات طلبات العمل من قبل هؤلاء الشباب، فتختار منهم ما تحتاج ممن تشاء ويبقى الآخرون في لائحة الانتظار حتى تكبر المؤسسة !. ولذلك نجد هذه المؤسسات في المستويات الأولى تعتمد على أساتذة رسميون ( ليس بالمفهوم القانوني) أي أنهم يشتغلون فقط في هذه المؤسسات دون غيرها، وعلى مدار الأسبوع، صباح مساء. وهؤلاء الأساتذة ذوو مستويات علمية مختلفة (الباكالوريا،Deug ، الإجازة....)، وفي تخصصات متعددة ( الآداب، العلوم، الحقوق...) وهذا شيء إيجابي بالمقارنة مع مؤسسات التعليم العمومي، لكن الشيء الأساسي الذي تفتقد إليه هذه الأطر الشابة هو التكوين في مجال التربية والتعليم، فأغلب هؤلاء الأساتذة يباشرون عملهم دون سابق تكوين. لكون هذه المؤسسات ليس لديها الوقت والاستعداد الكافيين لتكوين أطرها، لان هدفها أكبر من الأستاذ والتلميذ معا!. هذا باستثناء بعض المؤسسات التي تنظم دورات تكوينية، أياما قليلة قبل بداية الموسم الدراسي، غير أن مضمونها يكون بعيدا كل البعد عن واقع العمل داخل هذه المؤسسات، بل يكون الهدف منها توجيه الأساتذة وفق النظام السائد بالمؤسسة الذي يتماشى مع الأهداف الخاصة لصاحب المشروع. وهذا الواقع لا نجده في المؤسسات العمومية التي يخضع أطرها قبل الالتحاق للعمل بها لتكوين بيداغوجي وديداكتيكي وتجريبي في مراكز تكوين الأساتذة خلال مدة لا تقل عن سنة، يكتسب فيها الأستاذ آليات وأدوات منهجية تساعده على الاندماج في ميدان التعليم الذي يحتاج إلى شيء من الموهبة وكثير من التجربة!. أما الحديث عن وضعية هؤلاء الأساتذة المادية والقانونية فهنا الكارثة. فهي وضعية لا تخضع لقانون أو نظام ما، يسري على هذه المؤسسات باستثناء قانون الربح : فإذا كانت هذه المؤسسات حرة في فرض ما تشاء من رسوم تسجيل سنوية وواجبات شهرية (قد تصل إلى 1300 درهم شهريا للتلميذ في بعض المؤسسات)، فإنها تبقى حرة أيضا في تحديد أجرة الأستاذ الشهرية ( التي لا تتعدى 2000درهم)، باستثناء بعض أساتذة اللغة الفرنسية الذي تعرف المنطقة خصاصا إليهم بسبب قلة تخصص طلبة المنطقة في هذه الشعبة بالجامعة ، لذلك يتم جلبهم من المناطق المجاورة لمدينة الناظور مقابل بعض الامتيازات البسيطة كالسكن. وهذا على الوجه الأفضل.أما بعض المؤسسات فإنها تقتصر على تقديم تعويض عن ساعات العمل فقط (لا يتجاوز 40 درهم للساعة)، أما الساعات الأخرى وأيام العطل والعطلة الصيفية فهي أمور لا تهمها!. هذا دون أية ضمانات قانونية ، فمعظم هؤلاء الأساتذة تم تشغيلهم دون عقد أو شرط، باستثناء بعض المؤسسات التي تلجا للقانون قصد التحايل عليه والاستفادة منه، حيث يتم العقد بمشاركة طرف ثالث هوANAPIC، بموجب هذا العقد يعفى الطرفين من الحقوق الاجتماعية (CNSS) و(IGR) التي تتحملها الدولة، حيث يعتبر المستخدم(الأستاذ) مجرد متدرب(STAGIAIRE) لمدة سنتين، وهذا العقد غير ملزم للطرفين خلال هذه المدة، بحيث يتيح إمكانية فسخه من طرف المؤسسة المشغلة بالاستغناء عن الأستاذ في أي لحظة شاءت،أما إذا استمرت في العقد وتشبثت بالأستاذ فإنها تحرمه سنتين من حقوقه الاجتماعية الناجمة عن عمله وليس تدربه بالمؤسسة!.
هذه الإكراهات المادية و القانونية إلى جانب إكراهات أخرى ، مرتبطة بسلوكيات وتصرفات تمارس على الأستاذ داخل هذه المؤسسات (لا مجال للتفصيل فيها)، كلها تجعله يعيش واقعا مرا، وظروفا صعبة، يستحيل معها القيام بدوره على أحسن ما يرام، في تبليغ رسالته النبيلة، فيصبح بذلك مردوده ضعيفا ، مما ينعكس على مستوى التلاميذ، الذين وجههم آباءهم خصيصا إلى هذه المؤسسات بحثا عن المرد ودية، وتحت ضغط هؤلاء تضطر هذه المؤسسات للالتجاء إلى أساتذة التعليم العمومي ، خاصة في الأطوار المتقدمة وتستغني في النهاية عن أطرها الخاصة.
3- الهدف التربوي والتعليمي أو الإستراتيجية
إن إبراز الشروط المادية والبشرية التي تقوم عليها هذه المؤسسات، يقودنا للحديث عن هدفها وإستراتيجيتها. فهل هذه المؤسسات تمتلك إستراتيجية تربوية و تعليمية؟ أو بصيغة أوضح هل الذين يقفون وراء هذه المؤسسات يمتلكون رؤية مستقبلية واضحة: محورها طفل اليوم، رجل الغد. ومحيطها منطقتنا الريف وبلادنا المغرب؟
من المعروف أن أساس نجاح أي مشروع في أي مجال من المجالات يتوقف على صاحبه الذي يجب أن يكون منتميا إلى المجال الذي يريد الاستثمار فيه، أي ابن المجال كما يقال. بحيث لا يمكن أن نتصور في شخص واحد: فلاحا مثابرا في حقله ، صانعا ماهرا في مصنعه، تاجرا ناجحا في متجره، عالما باحثا في مخبره... فلكل حرفته التي يتقنها، وهذا في المجال الاقتصادي. أما إذا تحدثنا عن الاستثمار في مجال التربية و التكوين، فإن المسألة أكثر أهمية وتعقيدا. وتحتاج إلى خبرة كافية و دراسة دقيقة، وتخطيط كبير. لأن المشروع مشروع إنسان، ونتائجه بعيدة المنال، مرتبطة بالأجيال!.
إذا رجعنا إلى التاريخ وجدنا أن أصل المدارس والجامعات هي أفكار ونظريات تبلورت لدى مفكرين وفلاسفة في ميادين عدة، تم جمعها وتصنيفها إلى معارف وعلوم شتى، حاولوا استثمارها، فأنشئوا لذلك مؤسسات قصد نشرها وضمان استمراريتها وتطورها في الأجيال اللاحقة. وفي وقتنا الحاضر نجد في الدول المتقدمة، خبراء في مختلف الميادين،بعد أن يقضوا أعمارهم في البحث والتنقيب عن الحقائق العلمية، ينتهي بهم المطاف إلى إنشاء مدارس ومعاهد قصد تلقين خبراتهم للأجيال الناشئة ، وفق رؤيتهم المستقبلية التي تروم تطوير ما توصلوا إليه في أبحاثهم من نتائج ستؤدي إلى تقدم العلم والمعرفة عبر الأجيال. .إذا كان الأمر كذلك عند هؤلاء، فكيف هو الحال عندنا؟
إن أصحاب الميدان عندنا أي رجال التعليم يقضون معظم حياتهم في صراع مع الزمان ومصائبه، ولا يستطيعون بناء حتى منزل يؤويهم وأبناءهم ، وبالأحرى القيام بمشروع مؤسسة تعليمية . فمعظم الذين يقومون بهذه المشاريع هم أناس لا تربطهم بميدان التعليم أية صلة، فقط امتلكوا أموالا فاستثمروها في بناء مؤسسات أصبحت تدر عليهم أرباحا طائلة ، بل إن فيهم من لا يمتلك حتى مستوى دراسي. فكيف به أن يسير مؤسسة تعليمية ويمتلك إستراتيجية تربوية؟ فهل يكفي أن يكون الإنسان مقاولا في البناء ليشيد مدرسة!؟ قد يقال بأن صاحب المشروع ليس بالضرورة هو من يشرف على المؤسسة، بل يعهد ذلك إلى طاقم من الأطر التي لها دراية بالميدان ، وهذا واقع حقا في عدد من هذه المؤسسات، ولكن أليس المنطق الذي يحكمها هو منطق صاحبها ، والأطر المسيرة تبقى مجرد أدوات ووسائل مسخرة لخدمة أهداف صاحب المشروع؟
ويكفي مثالا على ذلك أن المدير أو الحارس العام داخل هذه المؤسسات، يخضع لرغبات التلميذ وأهواءه، انصياعا لأوامر صاحب المشروع ، الذي يعتبر التلميذ رقما صعبا في معادلة مشروعه يجب احترامه، لأنه حسب منطقه زبونا، والزبون في المنطق التجاري ملكا. يتضح إذن بأن العقلية التي تتحكم في هذه المؤسسات تجارية، ليس هدفها تكوين الأجيال لبناء المنطقة والوطن، وإنما جمع الأموال لتوسيع الثروة في سباق مع الزمن. وفي الأخير نساءل هذه المؤسسات : أبهذا المنطق ستنبعث رسالة العرفان في منطقتنا وتحمل آفاقا لأجيالنا؟! أمام هذا الواقع المرير، الذي وصل إليه التعليم في منطقتنا وبلادنا عموما، حان الوقت لكي تفكر الدولة مليا في هذا القطاع لأنه أساس كل القطاعات:
- أولا: بإعادة الاعتبار إليه من خلال إصلاح جذري (وليس استعجالي) يشمل المرافق والمؤسسات، والأطر والكفاءات، والمناهج والبرامج والمقررات، حتى يعيد الثقة للأجيال الحالية ويزرع الأمل في الأجيال القادمة.
- ثانيا: بتوجيهها للقطاع الخاص وتقنينه ومراقبته، ليس على مستوى البرامج والمقررات فقط، ولكن على مستوى التنظيم ، بوضع قوانين تحدد شروط إنشاء المؤسسات الخاصة، والتزاماتها المالية والقانونية تجاه شركائها
وأطرها، وتحديد سقف أجور موحد للأساتذة المشتغلين في هذه المؤسسات حسب مستواهم الدراسي وكفاءتهم المهنية، وتمتعيهم بكافة حقوقهم الاجتماعية ، والسهر على تطبيق هذه القوانين، وذلك من أجل وضع حد للتسيب والفوضى اللذين يعرفهما هذا القطاع ، وجعله يلعب دورا مكملا للقطاع العمومي وليس بديلا عنه.

 التعليم الخصوصي بالريف.. هل هو البديل الأمثل عن التعليم العمومي ؟
التعليم الخصوصي بالريف.. هل هو البديل الأمثل عن التعليم العمومي ؟