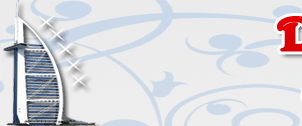حاوره: التجاني بولعوالي
ولج أحمد مركوش المعترك السياسي الهولندي، قبل أكثر من عقد زمني، تمكن خلاله من تعزيز موقعه؛ سياسيا وكاتبا داخل المشهد الثقافي والسياسي الهولندي، وهذا ما تؤكده الكثير من التجارب الشخصية والمهنية التي تراكمت لديه مع مرور الأيام، فصنعت منه وجها سياسيا لا يمكن إلغاؤه من راهن المعادلة السياسية الهولندية.
في هذا الحوار مع البرلماني الهولندي من أصل مغربي أحمد مركوش (43 سنة)، نميط اللثام عن جملة من القضايا الشخصية والسياسية والفكرية، التي تظل محط نقاش وصراع سواء داخل المجتمع الهولندي أم داخل أوساط الأقلية المسلمة والمغربية.
"من مجرد شرطي إلى نائب برلماني، وربما إلى وزير أو سكرتير في الحكومة الهولندية المنتظرة". لو تتفضلون أحمد مركوش بالحديث عن أهم جوانب مساركم الشخصي والسياسي؟
في الواقع، يتحدد أهم جانب في هجرتي من مسقط رأسي بويافار في منطقة الريف إلى هولندا عام 1979، وتحديدا عندما بلغت العاشرة من عمري، وقد تم ذلك في إطار قانون التجمع العائلي. وقد هاجرت وأنا أميّ لم يسبق لي الذهاب إلى المدرسة على الإطلاق، ولم أكن أعرف ولو النزر القليل سواء من العربية أم الفرنسية أم الهولندية. غير أنه بمجرد أن وطأت رجلي التراب الهولندي سوف تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تأتت لي فرصة عظيمة، فشعرت بأنني جد محظوظ بوجودي في عالم يمكّنني من تنمية شخصيتي وتطوير أدائي. وهكذا انخرطت في طور جديد وهو طور التمدرس والتكوين، فكان لزاما علي أن أدرس اللغة الهولندية بشكل مكثف عبر القراءة المتواصلة ومشاهدة التلفزة. هذا بالإضافة إلى تعلم اللغة العربية كل يوم أربعاء بعد الظهيرة وأثناء عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، ليصبح الأسبوع كله مخصصا للدراسة.
أن يكون وجودك حديث العهد في هولندا يعني هذا أن تبحث لك عن حيز داخل هذا المجتمع، مما يقتضي منك الكثير من الوقت والجهد لأن استنبات نقلة في غير أرضها وظروفها الطبيعية ليس بالسهولة التامة، وهذا ما ينطبق على المهاجرين وأطفالهم كذلك، الذين ينبغي لهم أن يتكيفوا مع المناخ الثقافي والاجتماعي الهولندي. إلا أن الجانب الإيجابي هنا هو أن هولندا بلد يمنحك العديد من الفرص والإمكانات، إن أنت استثمرتها بشكل جيد وعبر مجهود معقول، فسوف تكون النتيجة أيضا معتبرة. كما أقول دائما إن الحلم الهولندي لا يمكن أن يتحقق إلا بالعمل والمثابرة والتضحية، فالسماء لا تمطر ذهبا أو فضة! (حلمي الهولندي عنوان كتاب/سيرة ذاتية لأحمد مركوش).
وقد قادتني رحلة البحث إلى أن أتابع تكوينا تقنيا، لكني كنت ألاحظ أنني أميل كثيرا إلى خدمة الناس والمجتمع لا الاشتغال بالعمل التقني المحض وقضاء الوقت الطويل مع المعدات والآليات. فترتب عن ذلك أنني بعد هذا التكوين تسجلت في تخصص آخر يتعلق بالرعاية الصحية، ولعلي كنت يومها المغربي الوحيد الذي انتظم في هذا التكوين وذلك في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. غير أنه انقطعتُ بعد ذلك عن الدراسة لأجل العمل في المصنع، لأن الظروف المعيشية والاقتصادية آنذاك كانت عويصة تتطلب من المرء المزيد من المال لتغطية تكاليف الحياة. وبعد مدة معينة وجدت نفسي لا أطيق على ذلك العمل، وأن المال وحده لا يعني شيئا، وأنه لا يلبي الحاجة النفسية للفرد، فترشحت في آخر المطاف للعمل في الشرطة، إذ كنت وقتئذ في سن الثالثة والعشرين.
هل نصحك أي شخص آخر أو حفزك على العمل في الشرطة؟
لا، لم يشجعني أي شخص، بل كنت يومئذ لا أعرف أحدا من العائلة أو من المغاربة يعمل في ميدان الشرطة. وإنما تم ذلك عن اقتناع شخصي، لأنني كنت أجد ذلك ممتعا، فعندما كنت طفلا في بويافار كنا نتابع كل مساء يوم الأربعاء القناة الإسبانية، التي كانت تبث سلسلة بوليسية أثرت بشكل عميق في نفوسنا. ربما شكل ذلك نوعا من الاستلهام، إذ ظلت تلك المشاهد عالقة في ذاكرتي ووجداني، ثم إنني كنت أدرك أن عمل الشرطة ذو طابع اجتماعي، ما دام أن الشرطي يعمل على محاربة الظلم وتقديم مختلف الخدمات للناس والمجتمع.
لكن نشأَتْ في نطاق المجتمع الريفي صورة سلبية حول الشرطة والأمن، لأنها تحيل في الذاكرة الجمعية الريفية على السلطة والمخزن، وما كان يصدر منهما من قمع واضطهاد وتنكيل.
بالطبع، هذا صحيح. إلا أنني غادرت المغرب وأنا طفل لا علم لي بهذه الجوانب المأساوية، لكن من خلال احتكاكي بالطلبة الذين كانوا يفدون من المغرب على هولندا، كنا نسمع حكايات حول قمع المخزن والانتهاكات التي كانت تتعرض له الجامعات من قبل الشرطة، مما يعني أنني لم أكن أملك حقيقةً ذلك الإطار المرجعي. على عكس ذلك، فالأمر في هولندا مغاير جدا، لأن عمل الشرطة يتم في إطار مناخ ديمقراطي دقيق ومتطور. غير أن ثمة أمرا آخر، وهو أن الشرطة ترتبط في مخيلة المغاربة بمحاربة المخدرات، ولا تحيل على صور الاضطهاد وعدم الثقة، كما كان الشأن بالنسبة إلى المخزن في المغرب. من هذا المنطلق، فإن الشرطة هنا تشكل جهازا منفتحا على الجميع، يظل في خدمة المواطنين وليس ضدهم، وذلك من أجل توفير الأمن الكافي لهم، إذ أن الشعار المتداول في أمستردام فحواه أن الشرطة هي الصديق الأفضل للجميع.
فيما يتعلق بي شخصيا، قد شكلت الشرطة بالنسبة إلي فرصة ذهبية تعلمت منها الكثير من الدروس والتجارب. أتذكر أنه ذات يوم كنا بصدد النقاش حول قضية العنصرية بين أوساط الشرطة، فقال لنا أحد الأساتذة أن أمامكم، باعتباركم أجانب ومغاربة، تحديين؛ أولهما أن مجتمعكم المغربي لن يقبلكم، لأن عمل الشرطة يحيل لديهم على الخيانة و"الشكامة". ثم إن زملاءكم الهولنديين الأصليين سوف لن يقبلوكم كذلك، لأنكم أنتم أول المغاربة الذين اختاروا دراسة تخصص الشرطة. تداعت ذاكرتي حينئذ مباشرة إلى قصة وردت في المقرر الدراسي لأحمد بوكماخ. هذا الرجل المربي الذي ساهم بحق من خلال مقرراته المتميزة في تربية أجيال متتابعة وأثر فيها بشكل عميق. لا سيما وأن كتبه تتخذ طابعا أخلاقيا من خلال تقديم دروس ومواعظ متنوعة للنشء والطلبة.
تعتبر قصة الأرنب وأبنائها واحدة من القصص الممتعة والعميقة التي تعلمت منها الكثير، وقد تلقيتها في إطار التعليم الديني التقليدي الذي كنت أتلقاه في عطلة نهاية الأسبوع. وقد جاء في هذه القصة أن أحد صغار الأرنب سأل أمه: لماذا يتوفر غارنا على مخرجين؟! أجابته الأم بأنه سوف يأتي يوم فتعرف وتفهم لماذا منزلنا له بابان؟ وذات يوم تسلل ثعلب إلى داخل الغار، فما كان على الأرنب وأبنائها إلا الفرار عبر المدخل الثاني. عندما سمعت ملاحظة ذلك الأستاذ التي تبعث الخوف والتردد في النفوس، قلت في قرارة ذاتي علي أن أضع نفسي في الموقع ذاته الذي كانت فيه الأرانب، وأن أفكر دوما في مخرج آخر أفضل. وقد وجهني هذا الهاجس مباشرة بعد استكمال تكوين الشرطة إلى اختيار تخصص آخر أعلى منه، وهو تكوين أساتذة دراسة المجتمع. وكنت أثناء عملي شرطيا أدرس للتلاميذ كل يوم في الأسبوع مادة المجتمع. كما أنني كنت أختلف جذريا مع ذلك الأستاذ لأن الوضعية لا تعطى وإنما تؤخذ وتكتسب، وتترقى من خلال الجودة في العمل والتعامل، هذا ما كنت ولا أزال أعتقده شخصيا. وهكذا تمكنت مع مرور الأيام من تمتين وضعيتي في العمل، إذ كنت أقدم معية زملاء أجانب صورة جيدة وصحية حول عمل الشرطة للمغاربة والأجانب على وجه الخصوص، خصوصا وأننا كنا نتحدث بلسانهم ونحس همومهم، وهكذا بدأت تلك الصورة السلبية القديمة حول الشرطي تتبدد من ذاكرتهم وتفكيرهم. فضلا عن ذلك، تمكنت خلال عشر سنوات من عملي في ميدان الشرطة من الاطلاع عن كثب على مختلف المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي يتخبط فيها العديد من المغاربة والأجانب.
كما تجدر الإشارة إلى أنني تمكنت في تلك المرحلة (ما بين 12 و23) من إنشاء علاقات (بواسطة أخي) مع الكثير من الطلبة الذين درسوا في المغرب، والذين شكلوا بالنسبة إلي أنموذجا متميزا. لأنه من خلال الاحتكاك بهم تعمقت أكثر في الإسلام ودرست الكثير من المصادر، كما تعلمت قراءة وفهم اللغة العربية. في الحقيقة شكل لي ذلك المناخ الفكري والديني مدرسة مهمة، تعلمت فيها الكثير من الجوانب والمعاني الإسلامية السامية، التي تتجاوز ما هو عرقي وإثني ومادي، مما ساعدني في استيعاب الكثير من القضايا والمشاكل الاجتماعية والأخلاقية المتنوعة التي كنت أعايشها أثناء عملي في الشرطة.
لكن لماذا اخترت تكوينا تربويا يتعلق بأساتذة دراسة المجتمع؟ ما علاقة ذلك بمهنة الشرطة؟
كونك شرطيا يعمل ويتحرك طوال اليوم في عمق المجتمع، يعني هذا أنك تطلع وتتفاعل عن كثب مع الكثير من القضايا والمشاكل الاجتماعية. حقا، هذا ليس عمل الشرطي، لكن تعايش ذلك رغم أنفك وتراه بأم عينيك. بل وفي بعض الأحيان يتصل بك شخص ما في الليل، ليس لأن يخبرك بجريمة معينة، وإنما لأنه يشعر بالوحدة ويريد أن يتقاسم معك أطراف الحديث، فيختلق قضية ما حتى تتحدث معه.
بعد تجربة الشرطة الصعبة والثرية، سوف ينتقل الأستاذ أحمد مركوش إلى ميدان مغاير يجمع بين الممارسة السياسية والعمل الإداري. ماذا عن تجربتكم المتعلقة بترؤس بلدية سلوترفارت، التي كانت تعتبر آنئذ أصعب وأعقد بلدية على مستوى مدينة أمستردام؟
لا، بل أعقد وأصعب مقاطعة على المستوى الهولندي برمته، لأن أغلب المشاكل كانت حاضرة هناك بشكل مكثف وعارم! عندما بدأت عملي رئيسا لتلك البلدية، كالتطرف والاندماج والمخدرات وغير ذلك. ويعتبر مشروع محاربة التطرف أهم الخطوات العملية والاستراتيجية التي ساهمت بها، إعدادا وتنفيذا، وقد أتت أكلها في ومن قياسي. الفضل الأكبر يعود إلى أولئك الطلبة الذين شكلوا لي الإطار النظري والأخلاقي، الذي سوف يساعدني كثيرا على تطوير رؤية شخصية حول كيفية التعامل مع ظاهرة التطرف على سبيا المثال. إذ كنت الوحيد على مستوى أمستردام الذي كان خبيرا بهذا الأمر، فعلى أساس الملاحظة والمتابعة كنت أدرك هل الشخص متطرفا أم لا، وإلى أي تيار إسلامي ينتمي، إلى درجة أنني بدأت أميز بين جملة من الفروق والخصائص الدقيقة من مثل: هل ينتظم الشخص في التيار السلفي أو في أي تيار آخر؟ وكل تيار كان ينطوي على توجهات ثانوية متنوعة، وهكذا.
وكان منطلقي باستمرار أن الطابع الراديكالي لدى الطفل أو الشاب لا ينبغي أن يُجرم، بقدر ما ينبغي اعتباره مكونا أساسيا في تكوين شخصيته، قد يوجه بشكل إيجابي نحو تنمية الشخصية وخدمة المجتمع. على هذا الأساس يتحتم أن توجه الظاهرة الراديكالية بشكل متوازن قصد تقوية الجوانب الإيجابية في شخصية الطفل والشاب، أما إذا بقيت على حالها أو أنه يهون بها وتحتقر، فإنها سوف تتخذ لا محالة منحى منحرفا كما هو الشأن بالنسبة إلى محمد ب وسمير والكثير من الشباب المغاربة والمسلمين. هكذا يصبح الشاب من خلال التوجيه الجاد والتكوين المتوازن ذا شخصية قوية وفخورة بما حققته، خصوصا إن نجح في رحلة البحث عن الذات.
فيما يتعلق بالحرية فهناك حدود معينة لا ينبغي تجاوزها، وكنت أقول دوما للشباب (من أصل مغربي) الذين يتسكعون في شوارع أمستردام ويقفون عند زوايا الشوارع، كما كان يقول لي أبي: لقد منحت لكم فرص ذهبية يجب أن تستثمروها، وهي فرص لم تمنح لي ولا لجيلي؛ يمكن لكم الذهاب إلى المدرسة، إلى العمل، تملكون جوازا أحمر يمكن لكم أن تسافروا به إلى أية جهة في العالم. وإذا لم ترقكم هولندا فيمكن لكم أن تغادروا إلى بلد آخر، لا أن تضيعوا وقتكم وعمركم في التسكع. بل الغريب في الأمر، أن هناك من هؤلاء الشباب من يقول بأنه يحتاج إلى ناد في الحي لقضاء الوقت فيه، في حين أن هذه النوادي أقيمت خصيصا للفئة المتقاعدة لا للشباب. أسألهم بالله عليكم أين هي عقلية طارق بن زياد وشهامته؛ البحر هو التحدي والعدو هو الكسل والخمول، ربما هو العنصرية ومختلف الإغراءات.
أحمد مركوش ينظر إليه باعتباره شخصية خلافية لا سيما من قبل الكثير من المسلمين في هولندا، البعض يعتبره أنموذجا جيدا للنجاح الأجنبي، المغربي والإسلامي في الغرب، مقابل ذلك يرى فيه آخرون (تهديدا) للعديد من مصالح المسلمين والأجانب. ما هو رد فعلك إزاء مثل هذه الآراء والمواقف؟
ما تعلمته في المراحل السابقة وقد أثر في بشكل عميق، هو أنه إذا أردت أن تغير ظروفك الشخصية ينبغي أن تبدأ بتغيير نفسك أولا وقبل كل شيء. للأسف أن الكثير من الناس يجدون ذلك مزعجا. أضرب لك مثلا مهما وشائكا، وهو ظاهرة الشذوذ الجنسي والكيفية التي أتعامل بها معها، لا سيما في بلد ديمقراطي يضمن الحق والحرية لكل الفئات والأقليات، ومنها الشواذ الذين لهم الحق في ممارسة الحرية الشخصية بشكل تام، وفي أن يتزوجوا بشكل قانوني وعلني! غير أن عقلية الكثير من المسلمين لا تستوعب هذا الجانب، فإذا كنت تسعي إلى نيل الحرية والاحترام في هولندا والغرب، فينبغي لك كذلك أن تقدم الاحترام للآخرين، حيث لا يمكن أن نمضي قدما إلا إذا كنا نملك قدرة النقد الذاتي والتقييم الشخصي.
هناك قضية أخرى ذات طابع حساس لدى المغاربة والأجانب وهي مسألة التعويض الاجتماعي التي لا يجب أن تشكل للمواطن هدفا في الحياة يسعى جاهدا إلى تحقيقه، وإنما آلية أو طريقة لسد حاجة معينة ومؤقتة. لذلك لا يمكن أن نعتبره شيئا نفتخر به. هذا ما ينطبق أيضا على الجريمة التي لا ينبغي أن نسكت عنها، لا لشيء إلا لأنها تقترف من قبل أبنائنا، فالجميع سواسية أمام القانون، بل العكس يتحتم أن نساعد أبناءنا على تفادي اقتراف أي سلوك منحرف ومشين إذا كنا نحبهم حقا. من هذا المنطلق، لن نقدر على تأسيس مجتمع قوي إلا من خلال التقييم النفسي المستمر، والإيمان بأن المجتمع هو ملك للجميع وليس لشريحة على حساب أخرى. فإذا تم الاعتداء على امرأة أو تم سرقتها من قبل أجنبي أشعر بالغضب من ذلك السلوك، أما إذا سرقها مغربي، فإنني أغضب ثلاثة أضعاف أو أكثر!
ثم إنني سياسي ولست كوميديا. دخلت مجال السياسة عن اقتناع وليس من أجل المصلحة الشخصية، لأنني أؤمن بجملة من المبادئ والقيم، وأطمح إلى أن تصبح الأقلية المسلمة والمغربية في موقع جيد، في الوقت الذي نرى فيه أن الكثيرين ليسوا على جادة الصواب. لأنك إذا كنت تحب فئة أو مجموعة، فإنك تظل مسكونا بخدمتها والتضحية من أجلها، لا أن تتركها مثل بضاعة في يد مختلف الشركات والتيارات تتقاذفها وتتلاعب بها. كما أنه ينبغي الاعتراف بأن هذه الأقلية توجد على هامش المجتمع، في أحياء متردية ومدارس متأخرة ووضعية هشة...
إذن المسألة هي مسألة سوء فهم، حيث الكثير من المسلمين لم يستوعبوا بعد الخطاب الفكري والسياسي الذي يحمله الأستاذ أحمد مركوش. ثم إن هناك من يفسر هذا الخطاب بشكل متعسف وغير سليم.
في بعض الأحيان يمكن أن نرجع السبب إلى أنهم لا يريدون أن يسمعوا أو بالأحرى أن يفهموا هذا الخطاب. كما يمكن أن نرد ذلك أيضا إلى أن الكثيرين لا يدركون أنه إذا أرادوا تحقيق حريتهم الشخصية، فينبغي لهم كذلك حماية واحترام حرية الآخر الذي يختلفون معه ولا يتفقون مع رؤيته وثقافته واعتقاده. فإذا أردت أن تحقق هدفا في هذا المجتمع فيجب أن تتحرك شخصيا، لا أن تنتظر الآخرين لينوبوا عنك! كما هو سائد عند البعض الذي ينتظر من الغير أن يقدم له بعض الخدمات ويقضي له بعض الحوائج. إن الأمور لا تسير بهذا الشكل الغريب في الحياة. فإذا أردت تغيير ظروفك فما عليك إلا أن تحفز نفسك على القيام بمجهود معين. وهؤلاء ينطبق عليهم قول الشاعر: (ناموا ولا تستيقظوا /// ما فاز إلا النوم)!
الأستاذ أحمد مركوش، إذا سمحتم أود أن أربط هذا الوضع الحالك، الذي يسود لدى فئة معينة من المغاربة والأجانب بسؤال جوهري وهو: كيف تقيمون الإسهام المغربي داخل المجتمع الهولندي المتعدد الثقافات؟
في الحقيقة، أنا جد فخور بإسهام المغاربة في المجتمع الهولندي، بالمقارنة مع الحالتين البلجيكية والفرنسية، لأن المغاربة الهولنديين ليس لهم أي ارتباط ثقافي أو لغوي مع هذا البلد الذي استضافهم، فهم غرباء عنه تماما، في حين أن المغاربة الذين هاجروا إلى فرنسا وبلجيكا كان لهم معرفة معينة بذلك السياقين. لذلك فينبغي أن نقدر الأجيال الأولى التي جاءت إلى هولندا، التي شكلت لهم أول سياق مدني متطور يحتكون به، وهم لا يتمتعون بأي مستوى تعليمي وثقافي. ومع مرور الأيام تمكنوا من أن يعدوا ويربوا جيلا بأكمله ذو مستوى أكاديمي رفيع المستوى، يتصمن مختلف الكفاءات العلمية من أطباء متخصصين وجراحيين ومحامين وقضاة ومهندسين وإعلاميين وكتاب وسياسيين، وغير ذلك.
لكن الإعلام الهولندي يغيب هذا الجانب المشرق لإسهام المغاربة في المجتمع الهولندي؟
هناك حضور معين، للرياضيين مثلا. لعل بعض المشاكل الاجتماعية التي تسببها بعض العناصر المغربية تغطي على هذا الجانب، إذ عادة ما يركز عليها الإعلام الهولندي ويضخمها. الإنسان مجبول على التركيز على ما هو إشكالي، وهذا أعتبره من جهة ذا طابع إيجابي، لأن هذه المشاكل تصبح معروفة، حتى نساهم جميعا في إيجاد حلول ناجعة لها، ومن جهة أخرى يؤلمني لأن الكثيرين يوظفون هذا المعطى بشكل فاحش وغير مقبول، عندما يتخذونه مطية لزرع الخوف داخل المجتمع. وما أجده مخيبا للأمل أنه في نهاية الثمانينات تم التعامل مع هذه الإشكالات بلا مبالاة. ثم إن الإسلام يركز بشدة على تغيير المنكر، كيفما كان هذا المنكر، سواء أتعلق بالتزوير أم الكذب أم المخدرات أم غير ذلك. لكن للأسف فالعديد من المسلمين يغضون الطرف عن ذلك، ويتركون أبناءهم يسقطون في مختلف أنواع المحذورات والمناكر. فأضعف الإيمان أن نغير ذلك بالقلب، أن نتأثر لما يحدث ونتألم. على هذا الأساس، فأنا أفتخر جدا بالحضور المغربي الإيجابي في المجتمع الهولندي، غير أنني في الوقت نفسه أتعامل بشكل نقدي بناء مع بعض الظواهر المنحرفة والسلبية.
هو في الحقيقة حضور لافت للنظر، يحمل الكثير من الجوانب الإيجابية ويكشف عن أن قدم الأقلية المغربية بدأت تترسخ في الواقع الهولندي. ولعل الأستاذ أحمد مركوش خير دليل على هذا؛ باعتباره ذلك المهاجر الذي اندمج بشكل عميق وإيجابي في المجتمع الهولندي، ومع ذلك ما انفك يحافظ على جذوره المغربية، كيف تمارس أو تتعاطي، إذن، مع مغربيتك؟
في الحقيقة، الناس يحملون أكثر من هوية، إحدى أهم الهويات التي أحملها وأثمنها هي هويتي المغربية، كما أنني أعتز بكوني ولدت وترعرعت في المغرب؛ في بويافار. فهذا البلد يشكل لي متنفسا رائعا للراحة النفسية والاطمئنان وصلة الرحم وزيارة أصدقاء الطفولة.
لكن، أليس هذا يتناقض مع كونك تحمل الهوية الهولندية؟
لا، كما قلت فالإنسان يحمل أكثر من هوية، فيكون مغربيا ومسلما وما إلى ذلك. فيما يتعلق بالهوية الهولندية التي أحملها، وتتجلى من خلال المجتمع الهولندي الذي نعيش فيه، وندافع عن القيم والمصالح المشتركة التي نتقاسمها معا داخله، لنجعله مجتمعا قويا ومتماسكا، فنتمكن من تعبيد الطريق للأجيال القادمة. إن هذا الكمّ من الهويات التي يحملها الشخص تشكل عنصر قوة في شخصيته، ينبغي أن يستثمره بشكل جيد قصد الإسهام الإيجابي في الواقع الذي يعيش فيه، أما إذا تم التركيز على الجوانب الخلافية والمتصارعة في هذه الهويات، فإن ذلك لن يخدم المجتمع في شيء! لذلك فإنني أقول بكل اقتناع وثبات أنني مغربي هولندي مسلم أمازيغي... بكل هذه الهويات والألوان.
سؤالي الأخير هو أنه من المرتقب أن يصبح الأستاذ أحمد مركوش وزيرا أو كاتب دولة في الحكومة الهولندية القادمة، ما هو تعليقكم على ذلك؟
ذلك الاحتمال جد ضيق. الأهم من ذلك كله، أن أستمر بشكل قوي في ممارستي السياسية، وأن أساهم بجهودي الجادة في المشهد السياسي. وإذا حدث أن جاءت مثل تلك الفرصة، فسوف نعمل على تقييم ذلك الأمر في وقته المناسب.
ولج أحمد مركوش المعترك السياسي الهولندي، قبل أكثر من عقد زمني، تمكن خلاله من تعزيز موقعه؛ سياسيا وكاتبا داخل المشهد الثقافي والسياسي الهولندي، وهذا ما تؤكده الكثير من التجارب الشخصية والمهنية التي تراكمت لديه مع مرور الأيام، فصنعت منه وجها سياسيا لا يمكن إلغاؤه من راهن المعادلة السياسية الهولندية.
في هذا الحوار مع البرلماني الهولندي من أصل مغربي أحمد مركوش (43 سنة)، نميط اللثام عن جملة من القضايا الشخصية والسياسية والفكرية، التي تظل محط نقاش وصراع سواء داخل المجتمع الهولندي أم داخل أوساط الأقلية المسلمة والمغربية.
"من مجرد شرطي إلى نائب برلماني، وربما إلى وزير أو سكرتير في الحكومة الهولندية المنتظرة". لو تتفضلون أحمد مركوش بالحديث عن أهم جوانب مساركم الشخصي والسياسي؟
في الواقع، يتحدد أهم جانب في هجرتي من مسقط رأسي بويافار في منطقة الريف إلى هولندا عام 1979، وتحديدا عندما بلغت العاشرة من عمري، وقد تم ذلك في إطار قانون التجمع العائلي. وقد هاجرت وأنا أميّ لم يسبق لي الذهاب إلى المدرسة على الإطلاق، ولم أكن أعرف ولو النزر القليل سواء من العربية أم الفرنسية أم الهولندية. غير أنه بمجرد أن وطأت رجلي التراب الهولندي سوف تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تأتت لي فرصة عظيمة، فشعرت بأنني جد محظوظ بوجودي في عالم يمكّنني من تنمية شخصيتي وتطوير أدائي. وهكذا انخرطت في طور جديد وهو طور التمدرس والتكوين، فكان لزاما علي أن أدرس اللغة الهولندية بشكل مكثف عبر القراءة المتواصلة ومشاهدة التلفزة. هذا بالإضافة إلى تعلم اللغة العربية كل يوم أربعاء بعد الظهيرة وأثناء عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، ليصبح الأسبوع كله مخصصا للدراسة.
أن يكون وجودك حديث العهد في هولندا يعني هذا أن تبحث لك عن حيز داخل هذا المجتمع، مما يقتضي منك الكثير من الوقت والجهد لأن استنبات نقلة في غير أرضها وظروفها الطبيعية ليس بالسهولة التامة، وهذا ما ينطبق على المهاجرين وأطفالهم كذلك، الذين ينبغي لهم أن يتكيفوا مع المناخ الثقافي والاجتماعي الهولندي. إلا أن الجانب الإيجابي هنا هو أن هولندا بلد يمنحك العديد من الفرص والإمكانات، إن أنت استثمرتها بشكل جيد وعبر مجهود معقول، فسوف تكون النتيجة أيضا معتبرة. كما أقول دائما إن الحلم الهولندي لا يمكن أن يتحقق إلا بالعمل والمثابرة والتضحية، فالسماء لا تمطر ذهبا أو فضة! (حلمي الهولندي عنوان كتاب/سيرة ذاتية لأحمد مركوش).
وقد قادتني رحلة البحث إلى أن أتابع تكوينا تقنيا، لكني كنت ألاحظ أنني أميل كثيرا إلى خدمة الناس والمجتمع لا الاشتغال بالعمل التقني المحض وقضاء الوقت الطويل مع المعدات والآليات. فترتب عن ذلك أنني بعد هذا التكوين تسجلت في تخصص آخر يتعلق بالرعاية الصحية، ولعلي كنت يومها المغربي الوحيد الذي انتظم في هذا التكوين وذلك في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. غير أنه انقطعتُ بعد ذلك عن الدراسة لأجل العمل في المصنع، لأن الظروف المعيشية والاقتصادية آنذاك كانت عويصة تتطلب من المرء المزيد من المال لتغطية تكاليف الحياة. وبعد مدة معينة وجدت نفسي لا أطيق على ذلك العمل، وأن المال وحده لا يعني شيئا، وأنه لا يلبي الحاجة النفسية للفرد، فترشحت في آخر المطاف للعمل في الشرطة، إذ كنت وقتئذ في سن الثالثة والعشرين.
هل نصحك أي شخص آخر أو حفزك على العمل في الشرطة؟
لا، لم يشجعني أي شخص، بل كنت يومئذ لا أعرف أحدا من العائلة أو من المغاربة يعمل في ميدان الشرطة. وإنما تم ذلك عن اقتناع شخصي، لأنني كنت أجد ذلك ممتعا، فعندما كنت طفلا في بويافار كنا نتابع كل مساء يوم الأربعاء القناة الإسبانية، التي كانت تبث سلسلة بوليسية أثرت بشكل عميق في نفوسنا. ربما شكل ذلك نوعا من الاستلهام، إذ ظلت تلك المشاهد عالقة في ذاكرتي ووجداني، ثم إنني كنت أدرك أن عمل الشرطة ذو طابع اجتماعي، ما دام أن الشرطي يعمل على محاربة الظلم وتقديم مختلف الخدمات للناس والمجتمع.
لكن نشأَتْ في نطاق المجتمع الريفي صورة سلبية حول الشرطة والأمن، لأنها تحيل في الذاكرة الجمعية الريفية على السلطة والمخزن، وما كان يصدر منهما من قمع واضطهاد وتنكيل.
بالطبع، هذا صحيح. إلا أنني غادرت المغرب وأنا طفل لا علم لي بهذه الجوانب المأساوية، لكن من خلال احتكاكي بالطلبة الذين كانوا يفدون من المغرب على هولندا، كنا نسمع حكايات حول قمع المخزن والانتهاكات التي كانت تتعرض له الجامعات من قبل الشرطة، مما يعني أنني لم أكن أملك حقيقةً ذلك الإطار المرجعي. على عكس ذلك، فالأمر في هولندا مغاير جدا، لأن عمل الشرطة يتم في إطار مناخ ديمقراطي دقيق ومتطور. غير أن ثمة أمرا آخر، وهو أن الشرطة ترتبط في مخيلة المغاربة بمحاربة المخدرات، ولا تحيل على صور الاضطهاد وعدم الثقة، كما كان الشأن بالنسبة إلى المخزن في المغرب. من هذا المنطلق، فإن الشرطة هنا تشكل جهازا منفتحا على الجميع، يظل في خدمة المواطنين وليس ضدهم، وذلك من أجل توفير الأمن الكافي لهم، إذ أن الشعار المتداول في أمستردام فحواه أن الشرطة هي الصديق الأفضل للجميع.
فيما يتعلق بي شخصيا، قد شكلت الشرطة بالنسبة إلي فرصة ذهبية تعلمت منها الكثير من الدروس والتجارب. أتذكر أنه ذات يوم كنا بصدد النقاش حول قضية العنصرية بين أوساط الشرطة، فقال لنا أحد الأساتذة أن أمامكم، باعتباركم أجانب ومغاربة، تحديين؛ أولهما أن مجتمعكم المغربي لن يقبلكم، لأن عمل الشرطة يحيل لديهم على الخيانة و"الشكامة". ثم إن زملاءكم الهولنديين الأصليين سوف لن يقبلوكم كذلك، لأنكم أنتم أول المغاربة الذين اختاروا دراسة تخصص الشرطة. تداعت ذاكرتي حينئذ مباشرة إلى قصة وردت في المقرر الدراسي لأحمد بوكماخ. هذا الرجل المربي الذي ساهم بحق من خلال مقرراته المتميزة في تربية أجيال متتابعة وأثر فيها بشكل عميق. لا سيما وأن كتبه تتخذ طابعا أخلاقيا من خلال تقديم دروس ومواعظ متنوعة للنشء والطلبة.
تعتبر قصة الأرنب وأبنائها واحدة من القصص الممتعة والعميقة التي تعلمت منها الكثير، وقد تلقيتها في إطار التعليم الديني التقليدي الذي كنت أتلقاه في عطلة نهاية الأسبوع. وقد جاء في هذه القصة أن أحد صغار الأرنب سأل أمه: لماذا يتوفر غارنا على مخرجين؟! أجابته الأم بأنه سوف يأتي يوم فتعرف وتفهم لماذا منزلنا له بابان؟ وذات يوم تسلل ثعلب إلى داخل الغار، فما كان على الأرنب وأبنائها إلا الفرار عبر المدخل الثاني. عندما سمعت ملاحظة ذلك الأستاذ التي تبعث الخوف والتردد في النفوس، قلت في قرارة ذاتي علي أن أضع نفسي في الموقع ذاته الذي كانت فيه الأرانب، وأن أفكر دوما في مخرج آخر أفضل. وقد وجهني هذا الهاجس مباشرة بعد استكمال تكوين الشرطة إلى اختيار تخصص آخر أعلى منه، وهو تكوين أساتذة دراسة المجتمع. وكنت أثناء عملي شرطيا أدرس للتلاميذ كل يوم في الأسبوع مادة المجتمع. كما أنني كنت أختلف جذريا مع ذلك الأستاذ لأن الوضعية لا تعطى وإنما تؤخذ وتكتسب، وتترقى من خلال الجودة في العمل والتعامل، هذا ما كنت ولا أزال أعتقده شخصيا. وهكذا تمكنت مع مرور الأيام من تمتين وضعيتي في العمل، إذ كنت أقدم معية زملاء أجانب صورة جيدة وصحية حول عمل الشرطة للمغاربة والأجانب على وجه الخصوص، خصوصا وأننا كنا نتحدث بلسانهم ونحس همومهم، وهكذا بدأت تلك الصورة السلبية القديمة حول الشرطي تتبدد من ذاكرتهم وتفكيرهم. فضلا عن ذلك، تمكنت خلال عشر سنوات من عملي في ميدان الشرطة من الاطلاع عن كثب على مختلف المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي يتخبط فيها العديد من المغاربة والأجانب.
كما تجدر الإشارة إلى أنني تمكنت في تلك المرحلة (ما بين 12 و23) من إنشاء علاقات (بواسطة أخي) مع الكثير من الطلبة الذين درسوا في المغرب، والذين شكلوا بالنسبة إلي أنموذجا متميزا. لأنه من خلال الاحتكاك بهم تعمقت أكثر في الإسلام ودرست الكثير من المصادر، كما تعلمت قراءة وفهم اللغة العربية. في الحقيقة شكل لي ذلك المناخ الفكري والديني مدرسة مهمة، تعلمت فيها الكثير من الجوانب والمعاني الإسلامية السامية، التي تتجاوز ما هو عرقي وإثني ومادي، مما ساعدني في استيعاب الكثير من القضايا والمشاكل الاجتماعية والأخلاقية المتنوعة التي كنت أعايشها أثناء عملي في الشرطة.
لكن لماذا اخترت تكوينا تربويا يتعلق بأساتذة دراسة المجتمع؟ ما علاقة ذلك بمهنة الشرطة؟
كونك شرطيا يعمل ويتحرك طوال اليوم في عمق المجتمع، يعني هذا أنك تطلع وتتفاعل عن كثب مع الكثير من القضايا والمشاكل الاجتماعية. حقا، هذا ليس عمل الشرطي، لكن تعايش ذلك رغم أنفك وتراه بأم عينيك. بل وفي بعض الأحيان يتصل بك شخص ما في الليل، ليس لأن يخبرك بجريمة معينة، وإنما لأنه يشعر بالوحدة ويريد أن يتقاسم معك أطراف الحديث، فيختلق قضية ما حتى تتحدث معه.
بعد تجربة الشرطة الصعبة والثرية، سوف ينتقل الأستاذ أحمد مركوش إلى ميدان مغاير يجمع بين الممارسة السياسية والعمل الإداري. ماذا عن تجربتكم المتعلقة بترؤس بلدية سلوترفارت، التي كانت تعتبر آنئذ أصعب وأعقد بلدية على مستوى مدينة أمستردام؟
لا، بل أعقد وأصعب مقاطعة على المستوى الهولندي برمته، لأن أغلب المشاكل كانت حاضرة هناك بشكل مكثف وعارم! عندما بدأت عملي رئيسا لتلك البلدية، كالتطرف والاندماج والمخدرات وغير ذلك. ويعتبر مشروع محاربة التطرف أهم الخطوات العملية والاستراتيجية التي ساهمت بها، إعدادا وتنفيذا، وقد أتت أكلها في ومن قياسي. الفضل الأكبر يعود إلى أولئك الطلبة الذين شكلوا لي الإطار النظري والأخلاقي، الذي سوف يساعدني كثيرا على تطوير رؤية شخصية حول كيفية التعامل مع ظاهرة التطرف على سبيا المثال. إذ كنت الوحيد على مستوى أمستردام الذي كان خبيرا بهذا الأمر، فعلى أساس الملاحظة والمتابعة كنت أدرك هل الشخص متطرفا أم لا، وإلى أي تيار إسلامي ينتمي، إلى درجة أنني بدأت أميز بين جملة من الفروق والخصائص الدقيقة من مثل: هل ينتظم الشخص في التيار السلفي أو في أي تيار آخر؟ وكل تيار كان ينطوي على توجهات ثانوية متنوعة، وهكذا.
وكان منطلقي باستمرار أن الطابع الراديكالي لدى الطفل أو الشاب لا ينبغي أن يُجرم، بقدر ما ينبغي اعتباره مكونا أساسيا في تكوين شخصيته، قد يوجه بشكل إيجابي نحو تنمية الشخصية وخدمة المجتمع. على هذا الأساس يتحتم أن توجه الظاهرة الراديكالية بشكل متوازن قصد تقوية الجوانب الإيجابية في شخصية الطفل والشاب، أما إذا بقيت على حالها أو أنه يهون بها وتحتقر، فإنها سوف تتخذ لا محالة منحى منحرفا كما هو الشأن بالنسبة إلى محمد ب وسمير والكثير من الشباب المغاربة والمسلمين. هكذا يصبح الشاب من خلال التوجيه الجاد والتكوين المتوازن ذا شخصية قوية وفخورة بما حققته، خصوصا إن نجح في رحلة البحث عن الذات.
فيما يتعلق بالحرية فهناك حدود معينة لا ينبغي تجاوزها، وكنت أقول دوما للشباب (من أصل مغربي) الذين يتسكعون في شوارع أمستردام ويقفون عند زوايا الشوارع، كما كان يقول لي أبي: لقد منحت لكم فرص ذهبية يجب أن تستثمروها، وهي فرص لم تمنح لي ولا لجيلي؛ يمكن لكم الذهاب إلى المدرسة، إلى العمل، تملكون جوازا أحمر يمكن لكم أن تسافروا به إلى أية جهة في العالم. وإذا لم ترقكم هولندا فيمكن لكم أن تغادروا إلى بلد آخر، لا أن تضيعوا وقتكم وعمركم في التسكع. بل الغريب في الأمر، أن هناك من هؤلاء الشباب من يقول بأنه يحتاج إلى ناد في الحي لقضاء الوقت فيه، في حين أن هذه النوادي أقيمت خصيصا للفئة المتقاعدة لا للشباب. أسألهم بالله عليكم أين هي عقلية طارق بن زياد وشهامته؛ البحر هو التحدي والعدو هو الكسل والخمول، ربما هو العنصرية ومختلف الإغراءات.
أحمد مركوش ينظر إليه باعتباره شخصية خلافية لا سيما من قبل الكثير من المسلمين في هولندا، البعض يعتبره أنموذجا جيدا للنجاح الأجنبي، المغربي والإسلامي في الغرب، مقابل ذلك يرى فيه آخرون (تهديدا) للعديد من مصالح المسلمين والأجانب. ما هو رد فعلك إزاء مثل هذه الآراء والمواقف؟
ما تعلمته في المراحل السابقة وقد أثر في بشكل عميق، هو أنه إذا أردت أن تغير ظروفك الشخصية ينبغي أن تبدأ بتغيير نفسك أولا وقبل كل شيء. للأسف أن الكثير من الناس يجدون ذلك مزعجا. أضرب لك مثلا مهما وشائكا، وهو ظاهرة الشذوذ الجنسي والكيفية التي أتعامل بها معها، لا سيما في بلد ديمقراطي يضمن الحق والحرية لكل الفئات والأقليات، ومنها الشواذ الذين لهم الحق في ممارسة الحرية الشخصية بشكل تام، وفي أن يتزوجوا بشكل قانوني وعلني! غير أن عقلية الكثير من المسلمين لا تستوعب هذا الجانب، فإذا كنت تسعي إلى نيل الحرية والاحترام في هولندا والغرب، فينبغي لك كذلك أن تقدم الاحترام للآخرين، حيث لا يمكن أن نمضي قدما إلا إذا كنا نملك قدرة النقد الذاتي والتقييم الشخصي.
هناك قضية أخرى ذات طابع حساس لدى المغاربة والأجانب وهي مسألة التعويض الاجتماعي التي لا يجب أن تشكل للمواطن هدفا في الحياة يسعى جاهدا إلى تحقيقه، وإنما آلية أو طريقة لسد حاجة معينة ومؤقتة. لذلك لا يمكن أن نعتبره شيئا نفتخر به. هذا ما ينطبق أيضا على الجريمة التي لا ينبغي أن نسكت عنها، لا لشيء إلا لأنها تقترف من قبل أبنائنا، فالجميع سواسية أمام القانون، بل العكس يتحتم أن نساعد أبناءنا على تفادي اقتراف أي سلوك منحرف ومشين إذا كنا نحبهم حقا. من هذا المنطلق، لن نقدر على تأسيس مجتمع قوي إلا من خلال التقييم النفسي المستمر، والإيمان بأن المجتمع هو ملك للجميع وليس لشريحة على حساب أخرى. فإذا تم الاعتداء على امرأة أو تم سرقتها من قبل أجنبي أشعر بالغضب من ذلك السلوك، أما إذا سرقها مغربي، فإنني أغضب ثلاثة أضعاف أو أكثر!
ثم إنني سياسي ولست كوميديا. دخلت مجال السياسة عن اقتناع وليس من أجل المصلحة الشخصية، لأنني أؤمن بجملة من المبادئ والقيم، وأطمح إلى أن تصبح الأقلية المسلمة والمغربية في موقع جيد، في الوقت الذي نرى فيه أن الكثيرين ليسوا على جادة الصواب. لأنك إذا كنت تحب فئة أو مجموعة، فإنك تظل مسكونا بخدمتها والتضحية من أجلها، لا أن تتركها مثل بضاعة في يد مختلف الشركات والتيارات تتقاذفها وتتلاعب بها. كما أنه ينبغي الاعتراف بأن هذه الأقلية توجد على هامش المجتمع، في أحياء متردية ومدارس متأخرة ووضعية هشة...
إذن المسألة هي مسألة سوء فهم، حيث الكثير من المسلمين لم يستوعبوا بعد الخطاب الفكري والسياسي الذي يحمله الأستاذ أحمد مركوش. ثم إن هناك من يفسر هذا الخطاب بشكل متعسف وغير سليم.
في بعض الأحيان يمكن أن نرجع السبب إلى أنهم لا يريدون أن يسمعوا أو بالأحرى أن يفهموا هذا الخطاب. كما يمكن أن نرد ذلك أيضا إلى أن الكثيرين لا يدركون أنه إذا أرادوا تحقيق حريتهم الشخصية، فينبغي لهم كذلك حماية واحترام حرية الآخر الذي يختلفون معه ولا يتفقون مع رؤيته وثقافته واعتقاده. فإذا أردت أن تحقق هدفا في هذا المجتمع فيجب أن تتحرك شخصيا، لا أن تنتظر الآخرين لينوبوا عنك! كما هو سائد عند البعض الذي ينتظر من الغير أن يقدم له بعض الخدمات ويقضي له بعض الحوائج. إن الأمور لا تسير بهذا الشكل الغريب في الحياة. فإذا أردت تغيير ظروفك فما عليك إلا أن تحفز نفسك على القيام بمجهود معين. وهؤلاء ينطبق عليهم قول الشاعر: (ناموا ولا تستيقظوا /// ما فاز إلا النوم)!
الأستاذ أحمد مركوش، إذا سمحتم أود أن أربط هذا الوضع الحالك، الذي يسود لدى فئة معينة من المغاربة والأجانب بسؤال جوهري وهو: كيف تقيمون الإسهام المغربي داخل المجتمع الهولندي المتعدد الثقافات؟
في الحقيقة، أنا جد فخور بإسهام المغاربة في المجتمع الهولندي، بالمقارنة مع الحالتين البلجيكية والفرنسية، لأن المغاربة الهولنديين ليس لهم أي ارتباط ثقافي أو لغوي مع هذا البلد الذي استضافهم، فهم غرباء عنه تماما، في حين أن المغاربة الذين هاجروا إلى فرنسا وبلجيكا كان لهم معرفة معينة بذلك السياقين. لذلك فينبغي أن نقدر الأجيال الأولى التي جاءت إلى هولندا، التي شكلت لهم أول سياق مدني متطور يحتكون به، وهم لا يتمتعون بأي مستوى تعليمي وثقافي. ومع مرور الأيام تمكنوا من أن يعدوا ويربوا جيلا بأكمله ذو مستوى أكاديمي رفيع المستوى، يتصمن مختلف الكفاءات العلمية من أطباء متخصصين وجراحيين ومحامين وقضاة ومهندسين وإعلاميين وكتاب وسياسيين، وغير ذلك.
لكن الإعلام الهولندي يغيب هذا الجانب المشرق لإسهام المغاربة في المجتمع الهولندي؟
هناك حضور معين، للرياضيين مثلا. لعل بعض المشاكل الاجتماعية التي تسببها بعض العناصر المغربية تغطي على هذا الجانب، إذ عادة ما يركز عليها الإعلام الهولندي ويضخمها. الإنسان مجبول على التركيز على ما هو إشكالي، وهذا أعتبره من جهة ذا طابع إيجابي، لأن هذه المشاكل تصبح معروفة، حتى نساهم جميعا في إيجاد حلول ناجعة لها، ومن جهة أخرى يؤلمني لأن الكثيرين يوظفون هذا المعطى بشكل فاحش وغير مقبول، عندما يتخذونه مطية لزرع الخوف داخل المجتمع. وما أجده مخيبا للأمل أنه في نهاية الثمانينات تم التعامل مع هذه الإشكالات بلا مبالاة. ثم إن الإسلام يركز بشدة على تغيير المنكر، كيفما كان هذا المنكر، سواء أتعلق بالتزوير أم الكذب أم المخدرات أم غير ذلك. لكن للأسف فالعديد من المسلمين يغضون الطرف عن ذلك، ويتركون أبناءهم يسقطون في مختلف أنواع المحذورات والمناكر. فأضعف الإيمان أن نغير ذلك بالقلب، أن نتأثر لما يحدث ونتألم. على هذا الأساس، فأنا أفتخر جدا بالحضور المغربي الإيجابي في المجتمع الهولندي، غير أنني في الوقت نفسه أتعامل بشكل نقدي بناء مع بعض الظواهر المنحرفة والسلبية.
هو في الحقيقة حضور لافت للنظر، يحمل الكثير من الجوانب الإيجابية ويكشف عن أن قدم الأقلية المغربية بدأت تترسخ في الواقع الهولندي. ولعل الأستاذ أحمد مركوش خير دليل على هذا؛ باعتباره ذلك المهاجر الذي اندمج بشكل عميق وإيجابي في المجتمع الهولندي، ومع ذلك ما انفك يحافظ على جذوره المغربية، كيف تمارس أو تتعاطي، إذن، مع مغربيتك؟
في الحقيقة، الناس يحملون أكثر من هوية، إحدى أهم الهويات التي أحملها وأثمنها هي هويتي المغربية، كما أنني أعتز بكوني ولدت وترعرعت في المغرب؛ في بويافار. فهذا البلد يشكل لي متنفسا رائعا للراحة النفسية والاطمئنان وصلة الرحم وزيارة أصدقاء الطفولة.
لكن، أليس هذا يتناقض مع كونك تحمل الهوية الهولندية؟
لا، كما قلت فالإنسان يحمل أكثر من هوية، فيكون مغربيا ومسلما وما إلى ذلك. فيما يتعلق بالهوية الهولندية التي أحملها، وتتجلى من خلال المجتمع الهولندي الذي نعيش فيه، وندافع عن القيم والمصالح المشتركة التي نتقاسمها معا داخله، لنجعله مجتمعا قويا ومتماسكا، فنتمكن من تعبيد الطريق للأجيال القادمة. إن هذا الكمّ من الهويات التي يحملها الشخص تشكل عنصر قوة في شخصيته، ينبغي أن يستثمره بشكل جيد قصد الإسهام الإيجابي في الواقع الذي يعيش فيه، أما إذا تم التركيز على الجوانب الخلافية والمتصارعة في هذه الهويات، فإن ذلك لن يخدم المجتمع في شيء! لذلك فإنني أقول بكل اقتناع وثبات أنني مغربي هولندي مسلم أمازيغي... بكل هذه الهويات والألوان.
سؤالي الأخير هو أنه من المرتقب أن يصبح الأستاذ أحمد مركوش وزيرا أو كاتب دولة في الحكومة الهولندية القادمة، ما هو تعليقكم على ذلك؟
ذلك الاحتمال جد ضيق. الأهم من ذلك كله، أن أستمر بشكل قوي في ممارستي السياسية، وأن أساهم بجهودي الجادة في المشهد السياسي. وإذا حدث أن جاءت مثل تلك الفرصة، فسوف نعمل على تقييم ذلك الأمر في وقته المناسب.





 حوار مع الريفي أحمد مركوش الذي كان شرطيا فأصبح نائبا في البرلمان الهولندي
حوار مع الريفي أحمد مركوش الذي كان شرطيا فأصبح نائبا في البرلمان الهولندي