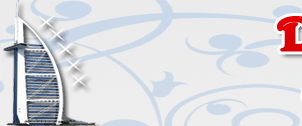فكري الأزراق
مرة أخرى يبين المخزن الإقصائي عن وجهه الحقيقي، ويؤكد بالملموس نهجه لسياسة الهروب إلى الأمام في تحد سافر لرغبة الشعب في العيش الكريم، متجاهلا بذلك القرارات القانونية والحقوقية الدولية التي تضمن للإنسان حريته وكرامته وحقه في الشغل والعيش الكريم والتعبير والاحتجاج السلمي...الخ، وهي –ويا للمفارقة- قرارات صادقت عليها الدولة المغربية في أكثر من مناسبة.
إن عملية القمع "المدبرة" والمخطط لها في "دهاليز دولة المخزن المغربية" والتي أسفرت عما يزيد عن 72 جريح بكل من الناظور من الحسيمة تطرح أكثر من سؤال حول علاقة الريف كمنطقة جغرافية وسكانية احتضنت أكبر حركة تحررية في العالم بالنظام السياسي المغربي الشديد التمركز في العاصمة الرباط، في وقت تطرح فيه الحركية المدنية والسياسية الريفية بدائل مختلفة للحكم في هذه المنطقة التي دفعت ثمن الإستقلال غاليا لتكون بالتالي عرضة للتهميش والإقصاء، وهو ما يزكي فرضية "الانتقام من أبناء الريف"، وإسكات أصواتهم المزعجة لرؤوس النظام السياسي الحاكم، ليعيد النظام السياسي نفس سيناريو المرحلة التي تلت استقلال إيكس ليبان الشكلي.
إن كل الإشارات تبين بالملموس استهداف النظام السياسي القائم لـــ "السلامة البدنية والجسدية للريفيين" فالاستعمال المفرط والهمجي للقوة ضد احتجاجات سلمية تطالب بالحق المشروع والعادل المتمثل في الشغل والعيش الكريم لا يمكن تبريره بكل شكل من الأشكال، كما أن تخريب الممتلكات من طرف قوات القمع بهدف إلصاق تهمة "التخريب" بالمحتجين يؤكد بما لا يترك مجالا للشك بأن الدولة تبحث فقط على أسباب قمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية التي تتحرك على طول وعرض البلاد مسببة بذلك إحراجا للنظام الذي بذل في الفترة الأخيرة مجهودات كثيرة لتزيين وجهه من خلال آليات مختلفة (الدستور الجديد، انتخابات سابقة لأوانها، خطابات رنانة، الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين...الخ) إلا أن سياسة الهروب إلى الأمام التي ينهجها ذات النظام في التعامل مع الملف المطلبي للحركات الاحتجاجية تضرب كل آلياته التزينية بعرض الحائط، وتبين زيف شعاراته، ولنا في التاريخ السياسي المعاصر محطات كثيرة من شد الحبل بين النظام المركزي ومطالب الحركات الاحتجاجية بالهوامش.
ومن جانب آخر، يبين القمع الأخير زيف خطاب "المصالحة" مع منطقة الريف التي لها تاريخ طويل من الصراع غير المتكافئ مع النظام المركزي، الذي لم يتردد قط في قمع الأصوات الحرة التي تطالب بالتوزيع العادل للسلطة والثروة، كما حدث في المحطات التي ستبقى منقوشة بحبر من دم وذهب في ذاكرتنا الجماعية، وستبقى "نقطة سوداء في جبين النظام المغربي الحاكم" في 1958/1959 وفي شتاء 1984. وكما يحدث اليوم مع المناضلين والمناضلات بالريف، سواء المنضوون تحت لواء الإطار العتيد "الجمعية الوطنية لحملة الشهادات" أو في باقي التنظيمات والحركات الاحتجاجية الأخرى، الذين يكررون نفس مطالب الحركات الاحتجاجية التي عرفها الريف على مر البساط الزمني الممتد منذ استقلال إيكس ليبان الشكلي، وقوامها –أي المطالب- الشغل والعيش الكريم، التوزيع العادل للسلطة والثورة، حق منطقة الريف في تدبير وتسيير شؤونها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بنفسها، ودون التدخل المفرط للمركز..... ما أشبه اليوم بالبارحة..
وجدير بالذكر في هذا المضمار، أن "القمع المتزايد" هي مقاربة الدولة لمعالجة معضلة البطالة وباقي الإشكاليات التي يمكنها أن تدمي أصابع الحكومة الملتحية التي لم يمض على بدء اشتغالها إلا أسابيع معدودة، وهو ما ينذر بصراعات مريرة ستطبع في هذه المرحلة حكومة بنكيران (الذي أطلق تصريحات عنصرية ضد المعطلين) وعموم الجماهير الشعبية، بالمغرب عامة وبالريف على وجه التحديد، المستاءة من طريقة التسيير الكارثية للشأن العام من طرف الحكومة الملتحية التي أرسلت وزيرها في العدل إلى جنيف لمناقشة وضعية حقوق الإنسان في الوقت الذي أعطت فيه أوامرها لأجهزة القمع لتعنيف المطالبين بالشغل والعيش الكريم. وهو ما تزكيه تصريحات الباكوري القائلة بـأن : "زمن المعارضة والاحتجاج قد ولى...".
ولا يخفى على أحد أن العلاقة بين السلطة وحركة المعطلين بالريف مطبوعة بالريبة والخوف مما يجعلنا أمام وضعية خطيرة ، ذلك أن رفض حركة المعطلين بالريف لأرباع وأنصاف الحلول يجعلها في خط مواجهة غير متوازي مع السلطة، وهو ما أثار حماسا أكبر لمواصلة الاحتجاج ، بل والرفع من سقف المطالب ، وفي هذا السياق فأن يكون النظام قد شرع في قمع متزايد لهو أمر يثير القلق، فكما أنه لا يجب فقط أن الوعود الممنوحة من هذه الجهة أو تلك يساوي في حد ذاتها حلول لمعضلة البطالة، بل يظن الوعود التي يطلقها كافية لوحدها . والحال أن التنكيل بالمناضلين والمناضلات وإشباعهم ضربا لإخلاء الطريق ، وإعطاء الأوامر لقوات القمع لتعنيف المحتجين وإشباعهم الضرب والجرح المفضي إلى عاهات مستديمة، لن تؤدي سوى إلى التنكر للنظام السياسي ومنع أي دعم له وإلى مزيد من التذمر والإستياء والسخط على النظام الفاشل والعاجز عن القيام بالمهام المنوطة به ، وبالتالي المطالبة بإسقاطه ربما.
مرة أخرى يبين المخزن الإقصائي عن وجهه الحقيقي، ويؤكد بالملموس نهجه لسياسة الهروب إلى الأمام في تحد سافر لرغبة الشعب في العيش الكريم، متجاهلا بذلك القرارات القانونية والحقوقية الدولية التي تضمن للإنسان حريته وكرامته وحقه في الشغل والعيش الكريم والتعبير والاحتجاج السلمي...الخ، وهي –ويا للمفارقة- قرارات صادقت عليها الدولة المغربية في أكثر من مناسبة.
إن عملية القمع "المدبرة" والمخطط لها في "دهاليز دولة المخزن المغربية" والتي أسفرت عما يزيد عن 72 جريح بكل من الناظور من الحسيمة تطرح أكثر من سؤال حول علاقة الريف كمنطقة جغرافية وسكانية احتضنت أكبر حركة تحررية في العالم بالنظام السياسي المغربي الشديد التمركز في العاصمة الرباط، في وقت تطرح فيه الحركية المدنية والسياسية الريفية بدائل مختلفة للحكم في هذه المنطقة التي دفعت ثمن الإستقلال غاليا لتكون بالتالي عرضة للتهميش والإقصاء، وهو ما يزكي فرضية "الانتقام من أبناء الريف"، وإسكات أصواتهم المزعجة لرؤوس النظام السياسي الحاكم، ليعيد النظام السياسي نفس سيناريو المرحلة التي تلت استقلال إيكس ليبان الشكلي.
إن كل الإشارات تبين بالملموس استهداف النظام السياسي القائم لـــ "السلامة البدنية والجسدية للريفيين" فالاستعمال المفرط والهمجي للقوة ضد احتجاجات سلمية تطالب بالحق المشروع والعادل المتمثل في الشغل والعيش الكريم لا يمكن تبريره بكل شكل من الأشكال، كما أن تخريب الممتلكات من طرف قوات القمع بهدف إلصاق تهمة "التخريب" بالمحتجين يؤكد بما لا يترك مجالا للشك بأن الدولة تبحث فقط على أسباب قمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية التي تتحرك على طول وعرض البلاد مسببة بذلك إحراجا للنظام الذي بذل في الفترة الأخيرة مجهودات كثيرة لتزيين وجهه من خلال آليات مختلفة (الدستور الجديد، انتخابات سابقة لأوانها، خطابات رنانة، الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين...الخ) إلا أن سياسة الهروب إلى الأمام التي ينهجها ذات النظام في التعامل مع الملف المطلبي للحركات الاحتجاجية تضرب كل آلياته التزينية بعرض الحائط، وتبين زيف شعاراته، ولنا في التاريخ السياسي المعاصر محطات كثيرة من شد الحبل بين النظام المركزي ومطالب الحركات الاحتجاجية بالهوامش.
ومن جانب آخر، يبين القمع الأخير زيف خطاب "المصالحة" مع منطقة الريف التي لها تاريخ طويل من الصراع غير المتكافئ مع النظام المركزي، الذي لم يتردد قط في قمع الأصوات الحرة التي تطالب بالتوزيع العادل للسلطة والثروة، كما حدث في المحطات التي ستبقى منقوشة بحبر من دم وذهب في ذاكرتنا الجماعية، وستبقى "نقطة سوداء في جبين النظام المغربي الحاكم" في 1958/1959 وفي شتاء 1984. وكما يحدث اليوم مع المناضلين والمناضلات بالريف، سواء المنضوون تحت لواء الإطار العتيد "الجمعية الوطنية لحملة الشهادات" أو في باقي التنظيمات والحركات الاحتجاجية الأخرى، الذين يكررون نفس مطالب الحركات الاحتجاجية التي عرفها الريف على مر البساط الزمني الممتد منذ استقلال إيكس ليبان الشكلي، وقوامها –أي المطالب- الشغل والعيش الكريم، التوزيع العادل للسلطة والثورة، حق منطقة الريف في تدبير وتسيير شؤونها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بنفسها، ودون التدخل المفرط للمركز..... ما أشبه اليوم بالبارحة..
وجدير بالذكر في هذا المضمار، أن "القمع المتزايد" هي مقاربة الدولة لمعالجة معضلة البطالة وباقي الإشكاليات التي يمكنها أن تدمي أصابع الحكومة الملتحية التي لم يمض على بدء اشتغالها إلا أسابيع معدودة، وهو ما ينذر بصراعات مريرة ستطبع في هذه المرحلة حكومة بنكيران (الذي أطلق تصريحات عنصرية ضد المعطلين) وعموم الجماهير الشعبية، بالمغرب عامة وبالريف على وجه التحديد، المستاءة من طريقة التسيير الكارثية للشأن العام من طرف الحكومة الملتحية التي أرسلت وزيرها في العدل إلى جنيف لمناقشة وضعية حقوق الإنسان في الوقت الذي أعطت فيه أوامرها لأجهزة القمع لتعنيف المطالبين بالشغل والعيش الكريم. وهو ما تزكيه تصريحات الباكوري القائلة بـأن : "زمن المعارضة والاحتجاج قد ولى...".
ولا يخفى على أحد أن العلاقة بين السلطة وحركة المعطلين بالريف مطبوعة بالريبة والخوف مما يجعلنا أمام وضعية خطيرة ، ذلك أن رفض حركة المعطلين بالريف لأرباع وأنصاف الحلول يجعلها في خط مواجهة غير متوازي مع السلطة، وهو ما أثار حماسا أكبر لمواصلة الاحتجاج ، بل والرفع من سقف المطالب ، وفي هذا السياق فأن يكون النظام قد شرع في قمع متزايد لهو أمر يثير القلق، فكما أنه لا يجب فقط أن الوعود الممنوحة من هذه الجهة أو تلك يساوي في حد ذاتها حلول لمعضلة البطالة، بل يظن الوعود التي يطلقها كافية لوحدها . والحال أن التنكيل بالمناضلين والمناضلات وإشباعهم ضربا لإخلاء الطريق ، وإعطاء الأوامر لقوات القمع لتعنيف المحتجين وإشباعهم الضرب والجرح المفضي إلى عاهات مستديمة، لن تؤدي سوى إلى التنكر للنظام السياسي ومنع أي دعم له وإلى مزيد من التذمر والإستياء والسخط على النظام الفاشل والعاجز عن القيام بالمهام المنوطة به ، وبالتالي المطالبة بإسقاطه ربما.





 قمع معطلي الريف، والتأويلات الممكنة
قمع معطلي الريف، والتأويلات الممكنة