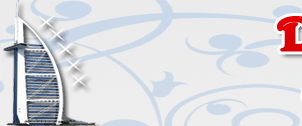إعداد: رضا سباعي
سننبش قليلا في طيات الماضي القريب، حين يعود بنا إلى الوراء الحاج الشركي، واحد من المغاربة الذين تم طردهم من الجزائر، ومن وهران على وجه التحديد، تلك المدينة التي نشأ وعاش فيها أزهى أيام شبابه، رفقة أعضاء فرقة الأزهر الموسيقية، والتي كان واحدا من مؤسسيها وأفرادها الذين أثاروا تعلق الشاب خالد بفنهم في مرحلة الطفولة…
لكن بطش جيراننا الجزائريين، لم يشأ لهذا الحاج أن يبقى وسط إخوانه وأحبابه، لا لشيء، سوى لكونه ينحدر من جذور مغربية، ساهم و آباؤه في صنع مجد و نصر، لبلد يطلق عليه أصحابه، بلد “المليون شهيد”.
سنروي لكم قراءنا الأعزاء، في أول حلقة من ملف” شاهد على حدث”، الأسباب البارزة والحقيقية لأبشع جريمة ارتكبت في حق مغاربة العالم، ألا وهي الطرد التعسفي من الجزائر.
تعود سنة طرد المغاربة من الجزائر إلى سنة 1965، مباشرة بعد انتهاء حرب الرمال ضد الحكومة المغربية، التي ألحقت بالجزائر هزيمة نكراء، قادتها آنذاك، شخصيات حربية وازنة داخل الجهاز العسكري الجزائري، والتي تربت على يد المخابرات الفرنسية، إذ التحقت بالثورة الجزائرية في آخر فتراتها، بهدف جني ثمار المقاومين الشرفاء والسطو والاستيلاء على ما غنموا به، والوصول إلى أعلى هرم للحكم، كهدف رئيسي لتصفية كل رموز الثورة التي دامت أزيد من عقد من الزمن.
“الهواري بومدين”، “عبد العزيز بوتفليقة” ومجموعة كبيرة من الضباط الفاسدين، وجدوا في المغرب فرصة للتعلم والتربية لم يشكروا المغاربة على نعمتهم عليهم، بل مزجوا دماؤهم بالحقد و الكراهية إزاء”المروك” أي المغرب حسب اللهجة العنصرية، إذ انتقلوا وانقلبوا في الجزائر على نظام الحاكم “بنبلا”، مدعين أنه يضم في صفوفه أطيافا من أبناء الخونة و ضباط المخابرات الفرنسية .
لكن هذه السياسة لن تتمكن من التحقق، ولن تتمكن من استقطاب تعاطف الشعب الجزائري المغلوب على أمره، إلا إذا وجد عدو خارجي، لتشويش أنظار الجزائريين صوبه، والتحريض على كراهيته، و ما زاد ” بومدين” حبا لمشروعه الفاسد، هو تصفيته لكل منافسيه و أعداءه، إلى أن أضحى الحاكم الأوحد للبلاد، يميت من يشاء، و يبقي الحياة لمن يريد… لذا أطلق العنان لزبانيته وجنوده، لتصفية المغاربة المقيمين ببلاده، و خصوصا العائلات التي كان يراها ذات شأن وباع كبيرين داخل المجتمع الجزائري.
ففي سنة 1963 بدأ ترحيل المغاربة تدريجيا، وازداد ذلك بعد الانقلاب على “الهواري بومدين” ونظامه سنة 1965، حيث بدأت ملاحقة كل المغاربة المحسوبين على نظام “بنبلا” وتصفيتهم فردا فردا، فمنهم من فر بجلدته إلى وطنه تاركا وراءه أحبابه وأقاربه، ومنهم من صعدت روحه إلى خالقها، من تلك البلاد، التي لم يتسنى لها أن تنسى مرارة 132 سنة من القتل و الترويع…
القرار الحكيم و النبيل لموحد البلاد المغفور له “الحسن الثاني” سنة 1975، الرامي إلى تنظيم مسيرة خضراء سلمية، من شمال البلاد إلى جنوبها، لم يكن له وقع سعيد عند أشقائنا، والذين حاولوا جاهدين في أكثر من ما مرة أن يشعلوا فتيل الفتنة مابين المغرب و جارتنا الشمالية إسبانيا، ليتيح في ما بعد لرفاق “بوتفليقة” الفرصة لتوسيع مخططاتهم التوسعية والوصول إلى المحيط الأطلسي، لتصدير صادراته من الذهب الأسود و الغاز الطبيعي، فما كان لهم إلا أن يختاروا يوم عيد الأضحى المبارك، بعدما عاد المصلون من تأدية صلاة العيد التي لم تكن كسابقاتها، مرتدين أحلى ثياب لهم، والتي لم تدع جانبا للتمييز بين انتماءاتهم العرقية ولا الفكرية.
فبينما الأسرة محلقة حول خروف العيد المعلق ببهو البيت و الأطفال مزهوين بأحلى لباس اقتناه لهم رب الأسرة، شرعت الآلة العسكرية والأمنية الجزائرية، باقتحام المساكن و مداهمة المواطنين، ليس لتهنئتهم بحلول هذا الحدث السعيد، بل للتفريق بين الأفراد، فكل مغربي سولت له نفسه ألا يصرح بكونه جزائريا، حكم عليه بالرحيل الآني…
وتحولت بذلك فرحة العيد إلى هستيريا وحزن شديدين، وسط أفراد من الأسر التي جمعت بينها أواصر الدم والقرابة، حيث تحولت الدعوات إلى ويلات، اغتصبت النساء وشردت العائلات، هناك من ترك إخوته، و ناك من تفرقت عن زوجها، أبيها، خالها وعمها، لا لشيء سوى لكونهم مغاربة، وبلا رحمة وشفقة، في يوم أنزل الله رحمته على نبيه، إذ نجى إسماعيل من الذبح، لكن جيراننا لم يروا بدا من هذه الموعظة الربانية.
فمباشرة بعد المداهمات، والإستنفارات الأمنية في كل ربوع “المغرب الأوسط”، أمر ضباط الشرطة الجزائريين، كل المغاربة المطرودين بحزم أمتعتهم بعدما جردوا من وثائقهم التي تثبت الهوية، وكذا الممتلكات العقارية والمالية ورحلوا بعدها صوب الحدود الجزائرية المغربية، حيث قدر العدد الإجمالي للنازحين بحوالي 45000 ألف أسرة مغربية، تحولت خلالها ساحة الشبيبة والرياضة بالناظور، بعد وصول المطرودين، إلى مخيم للاجئين، ظلوا قاطنين بها لفترة طويلة، موفرين لهم الماء و الطعام كهبة من الدولة المغربية.
سنتان من الانتظار وسط مخيمات ضيقة، لم تتسع لكل أفراد العائلة، وفرت بعدها الدولة توظيفات لرعاياها، حيث أرسل العديد إلى مؤسسات الدولة، لشغل منصب “شاوش” بالمحاكم، أو موظفين مرتبين في أدنى سلالم الأجور، بمرتبات لا تكفي حتى لشراء الشاي و الخبز.. أما بالنسبة للمأوى فقد تم تسليمهم حجرات أو بُيَيْتات ضيقة، لا تصل عشر ما تركوه في وهران أو الجزائر العاصمة..
أما الطامة الكبرى فهي حين حكم على الأرامل اللائي كن تقطن رفقة أزواجهن قيد حياتهم في مؤسسات تعليمية بالإفراغ، لم تسلمن هن الأخريات من دعاوي عديدة، صادرة عن مؤسسات للدولة كنيابات التعليم، حيث كانت تلك الأحكام، تطبق بشكل مستعجل، خادمين بذلك حسب معتقداتهم، المصلحة العامة للبلاد..
فقبل الوصول إلى صياغة هذه الأسطر الأخيرة، التي روى لنا أطوارها “الحاج الشركي”، ما فتئت دموعه المنهمرة عن التوقف من جوفي عينيه اللتان شهدتا مرارة الذل والاحتقار، جارا رفقة زوجته بنتيه وولديه البكرين، وبطانية قد تقي عائلته الصغيرة قساوة الرحلة…
لحظات من الأمل و السعادة تركها في وهران رفقة أعضاء فرقة الأزهر الموسيقية، والتي كان واحدا من أعضاءها وعازفيها، إذ أحيوا ليال جميلة في ربوع عديدة من التراب الجزائري والفرنسي مرفوقين بمتابعة و شغف” الشاب خالد” واحد من معجبي فرقة الأزهر في تلك الحقبة.. فهل ياترى سيحين موعد اللقاء الذي طال انتظاره؟ أم أن الهاتف سيبقى الرابط بين ضفتين شقيقتين، حكمت على بعدهما وفراقهما عناصر ظالمة من الجارة الشقيقة؟
سننبش قليلا في طيات الماضي القريب، حين يعود بنا إلى الوراء الحاج الشركي، واحد من المغاربة الذين تم طردهم من الجزائر، ومن وهران على وجه التحديد، تلك المدينة التي نشأ وعاش فيها أزهى أيام شبابه، رفقة أعضاء فرقة الأزهر الموسيقية، والتي كان واحدا من مؤسسيها وأفرادها الذين أثاروا تعلق الشاب خالد بفنهم في مرحلة الطفولة…
لكن بطش جيراننا الجزائريين، لم يشأ لهذا الحاج أن يبقى وسط إخوانه وأحبابه، لا لشيء، سوى لكونه ينحدر من جذور مغربية، ساهم و آباؤه في صنع مجد و نصر، لبلد يطلق عليه أصحابه، بلد “المليون شهيد”.
سنروي لكم قراءنا الأعزاء، في أول حلقة من ملف” شاهد على حدث”، الأسباب البارزة والحقيقية لأبشع جريمة ارتكبت في حق مغاربة العالم، ألا وهي الطرد التعسفي من الجزائر.
تعود سنة طرد المغاربة من الجزائر إلى سنة 1965، مباشرة بعد انتهاء حرب الرمال ضد الحكومة المغربية، التي ألحقت بالجزائر هزيمة نكراء، قادتها آنذاك، شخصيات حربية وازنة داخل الجهاز العسكري الجزائري، والتي تربت على يد المخابرات الفرنسية، إذ التحقت بالثورة الجزائرية في آخر فتراتها، بهدف جني ثمار المقاومين الشرفاء والسطو والاستيلاء على ما غنموا به، والوصول إلى أعلى هرم للحكم، كهدف رئيسي لتصفية كل رموز الثورة التي دامت أزيد من عقد من الزمن.
“الهواري بومدين”، “عبد العزيز بوتفليقة” ومجموعة كبيرة من الضباط الفاسدين، وجدوا في المغرب فرصة للتعلم والتربية لم يشكروا المغاربة على نعمتهم عليهم، بل مزجوا دماؤهم بالحقد و الكراهية إزاء”المروك” أي المغرب حسب اللهجة العنصرية، إذ انتقلوا وانقلبوا في الجزائر على نظام الحاكم “بنبلا”، مدعين أنه يضم في صفوفه أطيافا من أبناء الخونة و ضباط المخابرات الفرنسية .
لكن هذه السياسة لن تتمكن من التحقق، ولن تتمكن من استقطاب تعاطف الشعب الجزائري المغلوب على أمره، إلا إذا وجد عدو خارجي، لتشويش أنظار الجزائريين صوبه، والتحريض على كراهيته، و ما زاد ” بومدين” حبا لمشروعه الفاسد، هو تصفيته لكل منافسيه و أعداءه، إلى أن أضحى الحاكم الأوحد للبلاد، يميت من يشاء، و يبقي الحياة لمن يريد… لذا أطلق العنان لزبانيته وجنوده، لتصفية المغاربة المقيمين ببلاده، و خصوصا العائلات التي كان يراها ذات شأن وباع كبيرين داخل المجتمع الجزائري.
ففي سنة 1963 بدأ ترحيل المغاربة تدريجيا، وازداد ذلك بعد الانقلاب على “الهواري بومدين” ونظامه سنة 1965، حيث بدأت ملاحقة كل المغاربة المحسوبين على نظام “بنبلا” وتصفيتهم فردا فردا، فمنهم من فر بجلدته إلى وطنه تاركا وراءه أحبابه وأقاربه، ومنهم من صعدت روحه إلى خالقها، من تلك البلاد، التي لم يتسنى لها أن تنسى مرارة 132 سنة من القتل و الترويع…
القرار الحكيم و النبيل لموحد البلاد المغفور له “الحسن الثاني” سنة 1975، الرامي إلى تنظيم مسيرة خضراء سلمية، من شمال البلاد إلى جنوبها، لم يكن له وقع سعيد عند أشقائنا، والذين حاولوا جاهدين في أكثر من ما مرة أن يشعلوا فتيل الفتنة مابين المغرب و جارتنا الشمالية إسبانيا، ليتيح في ما بعد لرفاق “بوتفليقة” الفرصة لتوسيع مخططاتهم التوسعية والوصول إلى المحيط الأطلسي، لتصدير صادراته من الذهب الأسود و الغاز الطبيعي، فما كان لهم إلا أن يختاروا يوم عيد الأضحى المبارك، بعدما عاد المصلون من تأدية صلاة العيد التي لم تكن كسابقاتها، مرتدين أحلى ثياب لهم، والتي لم تدع جانبا للتمييز بين انتماءاتهم العرقية ولا الفكرية.
فبينما الأسرة محلقة حول خروف العيد المعلق ببهو البيت و الأطفال مزهوين بأحلى لباس اقتناه لهم رب الأسرة، شرعت الآلة العسكرية والأمنية الجزائرية، باقتحام المساكن و مداهمة المواطنين، ليس لتهنئتهم بحلول هذا الحدث السعيد، بل للتفريق بين الأفراد، فكل مغربي سولت له نفسه ألا يصرح بكونه جزائريا، حكم عليه بالرحيل الآني…
وتحولت بذلك فرحة العيد إلى هستيريا وحزن شديدين، وسط أفراد من الأسر التي جمعت بينها أواصر الدم والقرابة، حيث تحولت الدعوات إلى ويلات، اغتصبت النساء وشردت العائلات، هناك من ترك إخوته، و ناك من تفرقت عن زوجها، أبيها، خالها وعمها، لا لشيء سوى لكونهم مغاربة، وبلا رحمة وشفقة، في يوم أنزل الله رحمته على نبيه، إذ نجى إسماعيل من الذبح، لكن جيراننا لم يروا بدا من هذه الموعظة الربانية.
فمباشرة بعد المداهمات، والإستنفارات الأمنية في كل ربوع “المغرب الأوسط”، أمر ضباط الشرطة الجزائريين، كل المغاربة المطرودين بحزم أمتعتهم بعدما جردوا من وثائقهم التي تثبت الهوية، وكذا الممتلكات العقارية والمالية ورحلوا بعدها صوب الحدود الجزائرية المغربية، حيث قدر العدد الإجمالي للنازحين بحوالي 45000 ألف أسرة مغربية، تحولت خلالها ساحة الشبيبة والرياضة بالناظور، بعد وصول المطرودين، إلى مخيم للاجئين، ظلوا قاطنين بها لفترة طويلة، موفرين لهم الماء و الطعام كهبة من الدولة المغربية.
سنتان من الانتظار وسط مخيمات ضيقة، لم تتسع لكل أفراد العائلة، وفرت بعدها الدولة توظيفات لرعاياها، حيث أرسل العديد إلى مؤسسات الدولة، لشغل منصب “شاوش” بالمحاكم، أو موظفين مرتبين في أدنى سلالم الأجور، بمرتبات لا تكفي حتى لشراء الشاي و الخبز.. أما بالنسبة للمأوى فقد تم تسليمهم حجرات أو بُيَيْتات ضيقة، لا تصل عشر ما تركوه في وهران أو الجزائر العاصمة..
أما الطامة الكبرى فهي حين حكم على الأرامل اللائي كن تقطن رفقة أزواجهن قيد حياتهم في مؤسسات تعليمية بالإفراغ، لم تسلمن هن الأخريات من دعاوي عديدة، صادرة عن مؤسسات للدولة كنيابات التعليم، حيث كانت تلك الأحكام، تطبق بشكل مستعجل، خادمين بذلك حسب معتقداتهم، المصلحة العامة للبلاد..
فقبل الوصول إلى صياغة هذه الأسطر الأخيرة، التي روى لنا أطوارها “الحاج الشركي”، ما فتئت دموعه المنهمرة عن التوقف من جوفي عينيه اللتان شهدتا مرارة الذل والاحتقار، جارا رفقة زوجته بنتيه وولديه البكرين، وبطانية قد تقي عائلته الصغيرة قساوة الرحلة…
لحظات من الأمل و السعادة تركها في وهران رفقة أعضاء فرقة الأزهر الموسيقية، والتي كان واحدا من أعضاءها وعازفيها، إذ أحيوا ليال جميلة في ربوع عديدة من التراب الجزائري والفرنسي مرفوقين بمتابعة و شغف” الشاب خالد” واحد من معجبي فرقة الأزهر في تلك الحقبة.. فهل ياترى سيحين موعد اللقاء الذي طال انتظاره؟ أم أن الهاتف سيبقى الرابط بين ضفتين شقيقتين، حكمت على بعدهما وفراقهما عناصر ظالمة من الجارة الشقيقة؟







 شاهد على الحدث.. الحاج الشركي يروي أحداث مؤلمة للطرد التعسفي من قبل الدولة الجزائرية
شاهد على الحدث.. الحاج الشركي يروي أحداث مؤلمة للطرد التعسفي من قبل الدولة الجزائرية